|
ماريَّا قباره
مَرثا أم مريم؟ تَهميش أم مساواة ؟ هذا السؤال الذي يطرح نفسه في تحدٍ كبير للاستفسار عن مكانة ودور المرأة في الكنيسة الأرثوذكسيّة. تعكسُ الصورتان الإنجيليتان لكلّ من مرثا ومريم مفهومَين مختلفَين عن المرأة، وتحدّدان الأدوار المختلفة المدعوة لتؤديها المرأة في الكنيسة الأرثوذكسيّة. ورأيت من المناسب اتخاذ هاتين الصورَتين الإنجيليَتين لمقاربة المكانة الحقيقيّة للمرأة في الكنيسة الأرثوذكسية والأدوار الناشئة فيها. يقول الإنجيليّ لوقا في الإصحاح العاشر منه: "وبَينَما هُم سائرون، دَخَلَ قَريَةً فَأَضافَتهُ امَرَأَةٌ اسمُها مَرتا. وكانَ لَها أُختٌ تُدعى مَريم، جَلَسَت عِندَ قَدَمَي الرَّبِّ تَستَمِعُ إِلى كَلامِه. وكانَت مَرتا مَشغولَةً بِأُمورٍ كَثيرَةٍ مِنَ الخِدمَة، فأَقبلَت وقالت: "يا ربّ، أَما تُبالي أَنَّ أُختي تَرَكَتني أَخدُمُ وَحْدي؟ فمُرها أَن تُساعِدَني" فأَجابَها الرَبُّ: "مَرتا، مَرتا، إِنَّكِ في هَمٍّ وارتِباكٍ بِأُمورٍ كَثيرَة، مع أَنَّ الحاجَةَ إِلى أَمرٍ واحِد. فَقدِ اختارَت مَريمُ النَّصيبَ الأّفضَل، ولَن يُنزَعَ مِنها". (38-42). إنّ نموذج مَرثا يعبّر عن المعايير الشرقيّة المتوارثة، ولذلك في ذلك العصر، حُجّم دور المرأة جاعلاً إياها محافظةً على الدور التقليديّ الذي رُسم لها في متابعة شؤونِ البيت الداخليّة دون الاهتمام لأيّ أمر خارجه، كشؤون المجتمع الاجتماعيّة المختلفة. فالقرارات التي تتخذها المرأة تتعلّق فقط بشؤون البيتِ الداخلية، كالأسرة، وتربية الأولاد. في حين أنّ مسائل الشؤون الخارجيّة، كالمسؤوليات الإدارية والمالية تبقى من اهتمام الرجل. وبالتالي، بقيت المرأة مختفية في مطبخ المنزل، لها دورٌ محدّد مرسوم لها، لا يمكن الحياد عنه. كان يسوع في بيت عنيا بمثابة معلّم يهوديّ"Rabin"، ومريم كانت تجلس عند قدميه تستمع إليه. مريم ليسَ لها حقّ في وضعيّة كهذه في المجتمع الذي كانت تنتمي إليه. بل كان عليها أن تكون على غرارِ مرثا أختها في خدمةِ البيتِ والمائدة. إلاّ أنّ يسوع مدحَ مريم التي خرجتْ من المطبخ، وجَلست عند قدميه تَسمع كلامه، فأصبحتْ تلميذة. نرى هنا موقف متحرّر كليًّا ليسوع في مواجهة نظام وقوانين وشرائع كانت تُسنّ في المجتمع الذي كان يعيش فيه. حريّة يسوع المُهمَّة هذه نراها في النصّ إذ يقول: "اختارَت مَريمُ النَّصيبَ الأّفضَل، ولَن يُنزَعَ مِنها". إنّه نموذج المرأة التلميذة التي تتبَع المعلّم، على قدم المساواة مع تلاميذه الرجال. نصٌّ أنثوي بامتياز لأنّه يُقَيِّم في النهاية امرأة متحرّرة من قواعد العَمل كمدبّرة منزلٍ أو مسؤولة عن المائدة. إنّ صورة مرثا هذه تعبّر عن الدور التقليدي لمكانة المرأة، في ذلك العصر، كصّورة مهمشّة في مجتمعها. هذا النموذج غير لائق لصورة الله في الإنسان، وغير مُنصفٍ بحقِّ المرأة. ولهذا واجهه المسيح بالقول: أنّ "مريم قد اختارت النّصيب الأفضل". وهذا الأمر يتعارض مع موقف الذين، مثل مرثا، لديهم مشكلة في تقبّل أنّ المرأة سامعة للكَلمة وتخدمها. فأتى مدح المسيح لمريم دعوة للقول بالتساوي على المستوى الوجوديّ المواهبيّ أولاً، وثانياً، على المستوى الاجتماعي- المؤسساتي. فأي نموذجٍ يفضلّه المجتمع الكنسيّ اليوم، مَرثا أم مريم ؟ يبدو أنّ يسوع المسيح يقبل دور مريم. بينما الكنيسة تفضّل دور مرثا. يعكس التمايز بين دوريّ مرثا ومريم صراع في فضاءِ الكنيسة بين المؤسسة والمَوهبة. بين الدور المؤسساتي للمرأة عن الدور الكاريزماتي- المواهبي لها. فالتمييز بين المؤسسة والموهبة – الشائع في مجال البحث الاجتماعي – لا يترك الكنيسة الأرثوذكسية غير متأثرة بهذا الطرح. فعلى الرغم من الإشادة بدور مريم، إلاّ أن دور مرثا اكتسب أهمية متزايدة على مرّ العصور متبعاً دوراً موازياً في مسار مأسسة الكنيسة. فعلى المستوى اللاهوتي- المواهبي يُعترف بالمكانة المتساوية لمريم في المجتمع الكنسيّ. أمّا على المستوى المؤسّساتي - الاجتماعي تعيش مرثا أدواراً محدّدة، أدواراً تمييزية، مُهمشة وأدنى قيمة، تمّ قبولها ومأسستها على نطاق واسع في المؤسسة الكنسيّة. المستوى المؤسّساتيّ هَيمن على المستوى اللاهوتي- المواهبي. وبينما سُلطّ الضوء من خلال تعليم الكنيسة الرسميّ على المكانة المتساوية للمرأة من ناحية الخلاص والقداسة والتقديس. لكي لا يُعتبر هذا التسجيل للنماذج الأنثوية كتصنيف مبسط، سنحاول أن نرى من خلال أمثلة محددة أبعادَ كلّ نموذج. فقول بولس الرسول عن مكانة المرأة له وقع أساسيّ، فقد أكَّد في رسالته إلى أهل غلاطيّة أنّه: "لا رجل ولا امرأة، بل الجميع واحد في المسيح يسوع" (غلا3: 28). فموقف المسيح تجاه المرأة وتعامله معها، جَلَبَ لها خدماتٍ وأفعالاً (بحسب بولس الرسول- الرجل) وقَادَها إلى لعبِ دور فعَّال في الكَنيسةِ الأولى. ونتيجة لذلك، في المجتمع المسيحيّ المبكّر، أخذت النساء أدوار مبشراتٍ ومعلماتٍ وشمَّاسات (رومية16: 1-16). ومع ذلك لم يتجنّب بولس الرسول، في عصره، المأسسة. كشفت محاولاته الأولى في مسألة تنظيم الكنيسة موقف آخر تجاه المرأة داخل المجتمع. فقدّم البنية البطريركيّة الهرمية للتنظيم الاجتماعيّ المهيمن إمّا من خلال تبعية المرأة للرجل في العائلة (أفسس5:21-33)، أو من خلال حظرها عن الكلام بشكلٍ عام، وتواجدها الخامل في المجتمع الكنسيّ (1كورنثوس11: 1-16، 1 تيموثاوس2: 9-14). وهذا هو سبب وجود التناقض الظاهر في رسائله الرعوية بين إعلانه الأساسيّ بشأن المساواة بين المرأة والرجل من جهة، وموقف خضوع المرأة من جهة ثانية. وبناءً على ما سبق، تقبلّت الكنيسة الأدوار المتمايزة للرجل والمرأة، عبر نتاج الزمن وترسيخ المأسسة، فقللت وحجّمت دور المرأة في المجتمع آنذاك. فالروح التي سادت في القرن الرابع لم تعكس روح المساواة للجماعة في الكنيسة الأولى، بل سادت روح البطريركيّة الهرمية. وفي كثير من الأحيان، لم تنجح الكنيسة في التأثير على المجتمع السائد وتغييره، بل على العكس، تأثرت به وتكّيفت معه. وإن تمّ الاعتراف بالمساواة بين الرجل والمرأة، إلاّ أن هذا الاعتراف أتى على أساسٍ خلاصي أخرويّ دون أن ينتقل إلى وعي وضمير التنظيم الكنسيّ. هذا التصنيف يؤكّده حقيقة وجود تنظيمٍ أخذت فيه المرأة تنافس الرجل في الحياة الروحيّة والنسكيّة خلال الحقبة البيزنطيّة. فتمّ تقييم المرأة في الفضاء الرهبانيّ، ونافست بجدارة الرجل في النسك والزهد، وتغلّبت على ضعف طبيعتها مُكتسبة فضائل "رجولية". ففي سياق الحياة الرهبانية، يتمّ إزالة الفروقات بين الجِنسين وتحقّق المرأة التكافؤ مع الرجل. فنَمت الأديرة النسائية واكتسبت مكانة وهَيبة، وخاصّة خلال الفترة النهائية لحكم الامبراطورية البيزنطية. فهل استطاعت أن تكون مجالاً فاعلاً ومخرجاً لشخصية المرأة ومواهبها؟ لكنّ الرهبنة بقيت على هامش الحياة الكنسيّة الرعائيّة محافظة على المواهب الشخصية. ومع الوقت وتدريجياً تناقصَ النشاط العام للمرأة مع إلغاء دور الشمَّاسات. وقد ترسخ التمييز القائم بين الرجل والمرأة، ودنّى دورها ومكانتها في عهد الامبراطورية العثمانية، وذلك لأسباب كثيرة منها سياسية واجتماعية معروفة. وبعد إنشاء الدولة اليونانيّة الحديثة في مطلع القرن التاسع عشر، فصلت الكنيسة أماكن مخصصة للرجال وأماكن مخصصة للنساء في المعبد معتبرةً هذا تقليدياً ومقدَساً. وتكرر موقف المؤسّسة الكنيسة اليونانيّة تجاه المرأة في القرن العشرين (خاصّة في مطلع الخمسينيات الماضية) عندما ارتكز اهتمام الكنيسة على لباس المرأة بأن يكون بسيطاً ومحتشماً "مسيحيّاً". وأخذ خطاب المجمع المقدّس يحافظ على إنتاج الموقف التقليدي تجاه المرأة في إطار مثله الأعلى ألا وهو المؤسسة البطريركيّة الهرميّة، أيّ التسلسل الهرمي وتوزيع الأدوار بين الجنسين: الرجل مسؤول عن الفضاء العام، أيّ المجتمع والدولة، والمرأة مسؤولة عن الفضاء الخاصّ، كما هو مسجّل لها في البيت كواقع اجتماعي. وقَونَن المجتمع الكنسيّ هذا الموقف، معززاً المُعطى التاريخي- التقليدي لسيادة الرجل على المرأة. في البحث عن دور مريم في المجتمع الحديث، وخاصّة بعد الحرب العالميّة الثانية، تغيّرت مكانة المرأة ببطء وثبات. فالعوامل المختلفة، كالتحضّر، ودخول المرأة في الإنتاج الاقتصادي، وفي حقل التعليم، والحقّ في التصويت، وتغيير الوضع التقليدي للمرأة، هيأت ظروفاً جديدة لمشاركتها في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية. فتولت المرأة أدواراً جديدة أدت بها إلى مراجعة مكانتها وقدرتها الإنتاجية الفعالة في المجتمع ككّل. وقد لعبت الحركات النسوية دوراً كبيراً في هذا الشأن. أدت هذه التغييرات الجديدة إلى إنهاك الكنيسة الأرثوذكسيّة، كما حال كافة الطوائف الأخرى، على الأقل، من الناحية النظرية لمكانة ودور المرأة في الكنيسة. وكان رأس الحَربة، في هذه الحالة المحدّدة، قضية كهنوت المرأة التي أثارها العالَم البروتستانتي. من ناحيةٍ أخرى، فإنَّ إعادة قراءة الكتاب المقدّس وفقاً لمعايير العلوم التفسيريّة الحديثة، وإعطاء أبعاداً جديدة في الأنطولوجيا والأنثروبولوجيا للوجه الأنثوي من خلال تجديد قراءاتنا للدراسات الآبائية، والرجوع إلى رؤية القرون الأربعة الأولى وإعادة اكتشاف التراث الذي أُهمل، لنعطي رؤية أرثوذكسيّة سليمة عن القضية المطروحة حول موضوع المرأة. ومن المعالم البارزة في هذا الصدد، المؤتمر الأرثوذكسيّ الذي عُقد في رودوس 30/10-7/11 1988، حول "مكانة المرأة في الكنيسة الارثوذكسيّة ومسألة كهنوت المرأة فيها". وفي موضوع مسألة رسامة المرأة، صادقَ المؤتمر على الموقف التقليديّ للكنيسة الأرثوذكسيّة بشأن هذه المسألة، مُشيرين إلى إعادة إحياء دور الشمَّاسات. وفي الوقت نفسه، نُوقش بشكلٍ عام دور ومكانة المرأة في الكنيسة الأرثوذكسيّة، وأكّد المؤتمر على المكانة الفريدة لدور المرأة في عملية الخلاص من خلال دور العذراء مريم، وفي الوقت نفسه أقرّ بضرورة مشاركة وتفعيل دور المرأة بشكلٍ أكمل في الحياة الكنسيّة. ومن هنا علينا أن نشير إلى أنّ تغيير الوضع التقليديّ للمرأة في المجتمع الحديث قد فُعّل بطريقة مزدوجة في الفضاء الكنسيّ: فمن ناحية، كما أشرنا سابقاً، قد أثرّ في الكنيسة بشكلٍّ عامّ بمسألة إعادة النظر في موضوع المرأة، ومن ناحية أخرى، مكَّنَّ العديد من النساء من الانخراط في الدراسات اللاهوتيّة. وإن أدى التغيير في الظروف الاجتماعية إلى زيادة نشاط المرأة في المجتمع بشكلٍ عام، فإنّنا نعتقد أنّ لاهوت الكنيسة الأرثوذكسيّة لا يعرقل أنشطة مماثلة في الفضاء الكنسيّ. ومن المؤسف، أنّه برغم تأكيد الكنيسة الأرثوذكسيّة بأنّ النساء والرجال متساوون في الوجود والكرامة والخلاص إلاّ أنَّ هذا الموقف لا يَظهر في الممارسة الكنسيّة اليوميّة. فمن التناقض، أن تجد المرأة الأرثوذكسيّة مشاركة في مراكز صنع القرار السياسيّ (في المجالس البلدية أو المحافظات أو الوزاريّة) ولا يهتمّ لصوتها أو وجودها في قرارات في مجالس الرعايا أو المطرانيات أو البطريركيات. فإذا أردنا أن نبحث عن تجارب من شأنها أن تساعدنا على رؤية مكانة أكثر توازناً للمرأة في الكنيسة، يمكننا استخدام ما هو إيجابي خارج المسيحيّة، وأيضًا، ويمكننا أيضاً أن نعود إلى التجربة المسيحيّة الأولى لنرى المكانة التنظيميّة والرعائيّة للمرأة فيها. على الكنيسة في عصرنا أن تبحث عن مواقف أكثر أصالة وأكثر "عفوية" حول دور المرأة، مستوحاة من الحالة المواهبيّة للمسيحيّين الأوائل. المشكلة الأساسية التي ظهرت في الكنيسة بشكلّ عام تكمن في الأهمية التي اكتسبتها المؤسسة الكنسيّة على حساب البُعد المواهبيّ. في كثيرٍ من الأحيان يتم اختزال قضية اجتماعية بالقول: تقليد "مقدّس" وبالتالي يصبح الأمر خجل ورهاب لمواجهتها "بحريّة". في تقليد الكنيسةِ علينا أن نميّز بين ما هو جوهري لا يتغيّر، عما هو خارجي ينتمي إلى البيئة الخارجية المحيطة، والتي تتغير بفعل التأثيرات واللغات والثقافات المختلفة. من المّميزات، اليوم، أنّ تتمّ مناقشة مكانة المرأة في الكنيسة، وذلك بسبب التغيرات الاجتماعيّة وتطور الحركات النسويّة التي دفعت المرأة إلى تحقيق وتحسين مكانتها. هناك حاجة ماسّة في عصرنا أن نضعَ كلام الرسول بولس "ليس ذكرٌ وأنثى، لأنّكم جميعاً واحدٌ في المسيح يسوع" موضع التنفيذ. يؤكّد القدّيس يوحنّا الرحيم- القرن السادس: "بأنّنا كلّنا متساوون، ويجب أن نصبح متساوين". ومن هنا علينا أن نفهم في الكنيسة اليوم وبشكلٍ أساسيّ، أن إعطاء الخدمة لمن يملك موهبة أو مواهب الخدمة. فإذا استطاعت الكنيسة بروح التمييز والإفراز أن ترى أنّ هذه المرأة أو هذا الرجل مدعو للخدمة بحسب مواهب الروح القدس فيه، إذ ذاك تستطيع الكنيسة أن تعطي خدمة لهذا الإنسان سواء كان رجلاً أم امرأة. تَستحق المرأة، صورة الله ومثاله، أن تُستعاد إلى ضمير التنظيم الكنسيّ، وهو ما يحتاج إلى نشوء حركة نسائيّة كنسيّة فاعلة تُمكّنها من اتخاذ أي دورٍ يناسبها بحسب قدرتها ومعرفتها وعِلمها وبحسب مواهب الروح القدس التي فيها وليس بحسب جِنسها.
0 Comments
يضيق ذرعك بالكلام عن نظريّة المؤامرة. هناك «عقول» لا ينفع العقل معها. لم تتعلّم أن تفكّر ولا تريد أن تفكّر. تفضّل اختزال العالم، وما يحصل فيه، بحفنة من المعادلات اللا-عقليّة ربّما لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، هذا إذا أردت أن أكون متفائلاً. الواتساب هو الوسيلة المفضّلة كي تنشر نظريّة المؤامرة نظريّاتها. فتجد الأصدقاء وأصدقاء الأصدقاء وبشراً لم يحصل لك شرف التعرّف إلى وجوههم الكالحة يمطرونك بتفاصيل نظريّة المؤامرة: من اللقاح الذي يهدف إلى التلاعب بالتركيبة الجينيّة للبشر وإصابتهم بالعقر بإيعاز من بيل غايتس، وصولاً إلى الصهيونيّة العالميّة التي تريد استعباد الناس مستغلّةً الجوائح وشيفرة اللقاحات المفبركة بين سور الصين العظيم وتمثال الحرّيّة في نيويورك.
أيّها السيّدات والسادة: القلق حيال دواء جديد يُختبر للمرّة الأولى شيء والمؤامرات الكونيّة شيء آخر. حين اخترع الطبّ في الستّينات حبّة منع الحمل، قامت قيامة الناس، ولا سيّما رجال دين، وتحوّل كثر إلى أطبّاء متضلّعين: مؤامرة على الإنسانيّة هدفها الحدّ من النسل، دواء جديد يتسبّب بالسرطان، علامة من علامات انقضاء الأزمنة. معظم هؤلاء الجهابذة كانوا من الرجال. الموضوع، إذاً، مرتبط بسيكولوجيا القمع لدى الذكور ولا علاقة له بالعلم. والدراسات التي قام بها العلماء بلا كلل طوال عقود أثبتت أنّ لا علاقة بين حبوب منع الحمل والإصابة بالسرطان لدى النساء. الأثر الجانبيّ الوحيد لهذا «الدواء» هو مزيد من الحرّيّة الجنسيّة لدى بنات حواء، والسلام. تستطيع أن تكون مع أو ضدّ. ولكن هذا شيء ونظريّة المؤامرة شيء آخر. القلق حيال دواء جديد مسألة طبيعيّة، والعقاقير الجديدة تحتاج إلى التجربة والاستقراء ومراكمة الخبرات. مرّةً أخرى للتذكير: العلماء والأطبّاء ليسوا الله الآب. هم بشر مثلنا يتعلّمون من التجربة، يخطئون ويصحّحون. لا يقومون بالتجارب على البشر، ولكن لا يمانعون أن يتلقّى المصابون بمرض عضال، إذا كان محكوماً عليهم بالموت، أدويةً تجريبيّةً إذا هم أرادوا ذلك. هذه عبقريّة العقل البشريّ وعبقريّة العلم المنبثق منه. يعترف بمحدوديّته، يجاهر بأنّه لا يعرف كلّ شيء، يخطئ ويصوّب. ويحاول في كلّ هذا أن يحافظ على الكرامة الإنسانيّة على قدر ما أوتي له من فهم. وحدهم أصحاب نظريّات المؤامرة يعرفون كلّ شيء، يفهمون في كلّ شيء، ويتنبّأون بكلّ شيء. حاولت في الأسابيع الأخيرة أن أقوم بعمليّة إحصائيّة بسيطة للأشرطة الكثيرة التي وصلتني على الواتساب والتي تروّج لنظريّة المؤامرة في ما يختصّ باللقاح ضدّ الكوفيد، وذلك بالنظر إلى مصادرها. لاحظت أنّ معظمها يأتي من أشخاص ينتمون، بطريقة أو بأخرى، إلى العالم العربيّ، علماً بأنّ لديّ، بحكم وجودي في ألمانيا، شبكة علاقات واسعة تتخطّى هذه المنطقة من العالم. يضاف إلى ذلك أنّ هذه «المصادر» تشكّل في معظمها شريحةً تتراوح بين الخمسين والخامسة والسبعين بالنظر إلى المستوى العمريّ. كيف نقرأ دلالات هذه الظاهرة؟ في تقديري، معظم هؤلاء تنشّأوا في حمى فلسفة تربويّة تضطلع فيها نظريّة المؤامرة بدور حاسم: من الكولونياليّة الإمبرياليّة المتآمرة على منطقتنا العربيّة وصولاً إلى المسعى «اليهوديّ» الصهيونيّ لابتلاع كلّ شيء والسيطرة على كلّ شيء. في هذا السياق، تحضرني ثورات الربيع العربيّ. ربّما يكون هذا الربيع في نظر بعضهم خريفاً أو شتاءً. ولكنّ تغيّر المجتمعات فعل تراكميّ. وعبقريّة الربيع العربيّ، التي ستبقيه «ربيعاً» حتّى نهاية الأزمنة، تكمن في أنّ شبابه تحرّروا من نظريّة المؤامرة وقالوا للحكّام الطغاة: المشكلة فيكم، لا في «الغرب» الذي تنسبون إليه أنّه يتآمر علينا. هذا تحوّل نوعيّ في الوعي يبنى عليه. طبعاً لم نصل بعد إلى مرحلة نقد تاريخ الطاغوت في تاريخنا عبر تشريحه وإخضاع كلّ جزيئيّة من جزيئيّاته للمساءلة النقديّة. في الشرق العربيّ، مثلاُ، تلذّذنا جميعنا بكتاب «صناعة الهولوكوست» لمؤلّفه نورمان فينكلشتاين. تعاطفنا مع الباحث اليهوديّ الذي يفنّد تعامل الصهيونيّة مع المحرقة النازيّة وشعرنا بأنّه يفصح عمّا يعتمل في دواخلنا من أفكار. ولكن لم يكتب أحد منّا حتّى اليوم كتاباً عن كيفيّة استغلال الأنظمة والإيديولوجيّات العربيّة، وحتّى بعض الفلسطينيّين، لقضيّة فلسطين، من تجميع الثروات مروراً بتفلّت السلاح وصولاً إلى قمع الحرّيّات وتقويض الدولة المدنيّة وطرد اليهود من مصر وسوريّا والعراق. متى يأتي التفكيك البنيويّ لنظريّات المؤامرة التي ما زالت تفتك بنا في الاجتماع والسياسة والدين؟ هذا يحتاج إلى جهد علميّ كثير، وإلى التسليم بمرجعيّة التحليل النقديّ في السياسة والتاريخ والاقتصاد، وإلى الاعتراف بأسبقيّة العقل على النقل وحقّ العقل في مساءلة المنظومات الغيبيّة التي تختزل ازدهار المجتمعات ببركات سوف يغدقها الله على البشر من عليائه على نحو آليّ إذا هم انصرفوا إلى طاعته والامتثال لوصاياه. أسعد قطّان |
Telosقضايا حاليّة أرشيف
|
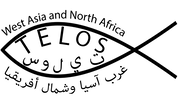
 RSS Feed
RSS Feed