|
الثلاثاء ٢٩ أيلول ٢٠٢٠
خريستوالمرّ "أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله" جملة طالما أسيء فهمها وفُسِّرَت على أنّها تعني أنّ المسيحية ديانة "روحيّة" لا كلمة لها تقولها في سياسات " الأرض". بالطبع هذا التفسير هراء عندما نتذكّر أنّ الإيمان المسيحيّ قائم على تجسّد كلمة الله في هذا العالم، بحيث أنّ هذا العالم صار في قلب الألوهة بعد القيامة. يستفيد من هذا الفكر الفصامي بين الأمور "الروحيّة" والأمور "الدنيويّة"، المنافقون والمستغلّون والمجرمون والديكتاتوريّون أيّما إفادة: فليتصرّف الإنسان بحسب ضرورات هذا العالم (و"الضرورات" مفهوم مطّاط) بينما يؤدّي في الوقت عينه واجباته "الروحيّة" التي تُختصر على أنّها اتّباع الطقوس. من آمنوا بيسوع يمكنهم أن يميّزوا بين الأرض والسماء ولكنّهم لا يفصلون بينهما، فالحياة هي كلّ واحد، وطريقة الحياة التي دعا إليها يسوع هي طريقة المحبّة، طريقة الحياة الإلهيّة، ونبّهنا أنّنا نمتلك كلّ الطاقات الضروريّة ("صورة الله") لكي نحياها. يتّفق العديد من المتأمّلين في جملة يسوع "أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله"على أنّها تعني أنّ هناك أولويّة لملكوت الله على ملكوت قيصر، وملكوت قيصر هو كلّ سلطة أرضيّة. يسوع بكلماته هذه حرّر الضمير الإنسانيّ من أن يستعبد نفسه لسلطة أرضيّة، ودعا كلّ إنسان أن يتحلّى بالشجاعة الروحيّة كي يحكم على ما تقوله وتفعله كلّ سلطة بناء على متطلّبات الحياة مع يسوع؛ فيرفض، مثلاً، كلّ قول وتفكير وفلسفة وحزب وقياديّ يدعو لتفوّق عنصريّ أو للعنف ضدّ الناس، ويرفض القيام بالتعذيب أو السكوت عنه، ويرفض أن يطلق النار على متظاهرين، ويرفض طاعة سلطة تنهب شعبها أو تقمعه، ويرفض كلّ دعوة من رجل دين للقبول بالظلم. في لبنان اليوم نحن بحاجة للعودة إلى جملة يسوع هذه بالذات ليحرّر الناس أنفسهم من سلطة «قيصر»، وقيصر اليوم هو في جمعيّة المصارف، وفي حاكميّة مصرف لبنان، وفي مجلس النوّاب، وفي مجلس الوزراء، وفي القصر الجمهوريّ، وفي رجال دين، وفي أساتذة جامعات وخبراء مرتزقة "يحاربون" لمن يدفع أكثر. هذا الصراع من أجل أن نتحرّر من سلطة «قيصر» ينبع منه وقوفٌ إلى جانب الحقّ، وهو ما يجعلنا في صدام مع النفاق، ليس لأنّ الإنسان يحبّ الصدام بل لأنّ المنافقين يكرهون الواقفين مع الحقّ، وقد كرهوا في كلّ زمنٍ أنبياءه، واضطهدوهم. ولهذا كان يسوع واضحًا "لا تظنّوا أنّي جِئْتُ لأُلقي سلاما على الأرض... إنّي جئت لأفرّق الإنسان ضدّ أبيه، والابنة ضدّ أمّها، والكنّة ضدّ حماتها. وأعداء الإنسان أهل بيته. من أحبّ أبًا أو أُمّا أكثر منّي فلا يستحقّني، ومن أحبّ ابنًا أَوِ ابنةً أكثر منّي فلا يستحقّني". كلمات مخيفة لكلّ بُنى سلطويّة يقولها السيّد فينسف بها كلّ سيطرةٍ، كما كلّ استكانة. كلام يسوع يعني أنّ يرفض الإنسان اتّباع كلّ خطّ سياسيّ وفكريّ طائفيّ أو عنصريّ أو مُلحق بالزعيم أو لا هدف له سوى دعم من ينهب البلاد، أو دعم من فشل من إيقاف نهبها، أو لأنّ أباه وأمّه وأخاه وأخته وأصدقاءه أو ابنه وابنته يتّبعونه، أو لأنّه سيشعر بالحرج وبالضيق وبالصراع وربّما سيشعر بالخزي وبالنبذ إن عارض الأهل والأصدقاء في مواقفهم. ولهذا بالضبط قال يسوع فورا بعد جملته الأخيرة "مَنْ لا يحمل صليبه ويتبعُني فلا يستحقّني". اتّباع الله صليب بالضرورة، ليس لأنّ الله يحبّ التعذيب بل لأنّ المنافقون وأتباعهم من فاقدي البصيرة يكرهون الحقيقة. إنّه لأسهل على الإنسان أن يبقى عبدا من أن يتحرّر. الحرّية صليبٌ وشيءٌ من فقدان الذات القديمة، الذات التي تلطّخت بالعبوديّة للزعيم والسياسي والمصرفيّ والعائلة والأصدقاء ولهذا أيضا قال يسوع "من وجد حياتها يضيّعها، ومَن أضاع حياته من أجلي يجدها" أي من ظنّ أنّه وجد حياته باستعباد ذاته لقياصرة هذا العالم، قياصرة العائلة والمجتمع والدين والسياسة، يكون قد فقدها ومن شعر بأنّه يخسر كلّ شيء لاتّباعه ضميره (ويسوع في ضميره) في الحقيقة يكون قد وجد ذاته، وهذا من أعظم ما يمكن لإنسان أن يحقّقه. يسوع أتى وقيصر ينازع، أن يكون الإنسان مع يسوع أمرا يتطلّب الشجاعة، شجاعة أن نخلع الإنسان العتيق لنصبح أناسًا جُددًا، ونصبح معًا وطنًا جديدًا.
0 Comments
١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ خريستو المرّ عادة ما ينسى الإنسان الموت ويتناساه. أمّا في حالتنا في هذه البلاد فنكاد نصبح أصدقاء للموت. في معظم سنوات عمرنا، كان رفيق قهوة الصباح ونشرة أخبار المساء، وصفحات ما بقي من جرائد. يتنزّه في بلادنا كيفما يشاء، ويمدّه سياسيّونا ورجال أدياننا بالعون دون تردّد. ولكنّنا نتكلّم عن الموت وكأنّه شيء خارجيّ، والواقع أنّ الموت داخليّ فينا، يبدأ بالنموّ في أجسادنا منذ لحظة ولادتنا؛ ننمو وينمو هو فينا. ولهذا كان نسيانه مشكلةً، ليس لأنّنا يجب أن نهجس بالموت، ولكن لأنّ من لم يعط معنى لموته لم يستطع أن يعطي معنى لحياته، ولم يستطع أن يحيا حرًّا لأنّنا لا نستعبد أنفسنا لآخرٍ إلاّ خوفًا من الموت. الحرّة والحرّ هما اللذان لحياتهما معنى أوسع من مجرّد البقاء على قيد الحياة، هما اللذان يريدان أن تتأجّج فيهما الحياة، ولهذا يرفضا أن يستعبدهما أحد ويتمسّكان بالمعنى وباشتعال الحياة فيهما حتّى ولو أدّى ذلك - في مفارقة ظاهريّة - إلى كلّ أنواع الموت: الوحدة، النبذ، تشويه الصيت، وحتّى القتل. وكلّ موت كهذا هو شهادة. كلّنا سنموت، السؤال المهمّ هو أيّ معنى سيكون لموتنا، أي بعبارة أخرى أيُّ معنى سيكون لحياتنا؟ كثيرون ماتوا في حروب أهليّة وقيل أنّهم ماتوا مجانًا: ماتوا من رصاصة طائشة، أو قذيفة بينما كانوا نياما، أو ذاهبين إلى العمل أو لشراء ربطة خبز. في الظاهر لا يبدو لموت هؤلاء الناس من معنى، فهم لم يحاربوا في جبهة دفاعًا عن أهلهم، ولا ماتوا نتيجة رأيهم السياسيّ. ولكن في العمق، من يعلم؟ ربّما قضى أحدهم حياته ساعيا لحماية حياة عائلته أو دفاعا عن حقّ أو احتجاجًا على الظلم، فإن كان الأمر كذلك فهناك معنى لموته بالنسبة له هو، هو الذي استشهد أثناء ممارسة حبّه اليوميّ. حياة إنسان كهذا مليئةٌ بالمعنى إن كان هو يرى أنّ أفعاله اليوميّة كانت تعبير حبّ، أنّه كان فيها يتواصل مع آخرين، ومع الطبيعة، ومع الله عند من يؤمن. عندها الحبّ هو المعنى. وهل من معنى أعلى، بل آخر، على هذه الأرض؟ المؤمنون بالله يمكنهم أن يروا بالموت عبورًا إلى واقع آخر، فهم يؤمنون أنّ محبّة الله ستمتدّ أمامهم جسرًا فوق فوّهة العدم لئلاّ يعودوا إلى العدم الذي منه خرجوا، يؤمنون بأنّ محبّة الله سترتمي إليهم كما ترمي أمٌّ بنفسها إذا وقع أحد أولادها كي لا يؤذى أو يعود إلى رحم الأرض التي منها الجميع، تريد لرحم الحبّ، رحمها، أن ينتصر على رحم الأرض، تريد أن ينتصر الحبّ على التراب. هكذا الله، كالأمّ، يرتمي إلينا بعد موتنا كي لا نعود إلى العدم، كي تنتصر رحمة حبّه على العدم. في كلّ ولادة تنتصر المحبّة الإلهيّة على العدم الذي منه نخرج، وفي كلّ لحظة تنتصر على العدم كي نبقى موجودين، وبعد الموت تنتصر على العدم لنحيا للأبد. إنّ محبّة الله تُنهي عدمنا يوم نولد. أمّا بالنسبة لمن لا يؤمن بالله، فيمكنه أن يقول: لست أدري عمّا تتحدّث ولكن أعلم أنّ المحبّة فيّ تناديني أن أحياها لأحيا. ظنّي أنّ ذلك يجعل القائل في قلب الله. قد يكون البشر قد اخترعوا الله، وقد يكونوا لم يخترعوه كما يؤمن كاتب هذه السطور، يبقى أنّ الإنسان مدفوعٌ على إعطاء معنى لحياته هو بالذات، ولا معنى أهمّ من أن يحيا الإنسان ذاته دون تزوير، لكي تغدو حياةً متأجّجةً، وشرط هذا أن يحيا في فرادته، ويرفض أن يكون كما شاء آخر له أن يكون. أن يكون الإنسان ذاته هو أن يحقّق كلّ ما يقول فيه أنا، ويحقّق كلّ ما يقول فيه نحن. عندها يكون نفسه ويكون مُحِبًّا، وهذا تحقيق للشخص الإنسانيّ صورة الشخص الإلهيّ: أقنوم محبّة يجمع فرادته التامّة في الوحدة التامّة مع آخرين. هذه المحبّة هي نبع الحياة التي تبتلع كلّ عدم، وتكسر شوكة كلّ موت. |
Telosقضايا حاليّة أرشيف
|
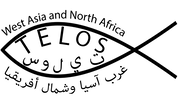
 RSS Feed
RSS Feed