|
ماريَّا قباره
إنَّ التواجد في العالم الرقميّ اليوم باتَ حقيقة لا خياراً. وقد شكّلت هذه التكنولوجيا المتسارعة تحديّاً طارئاً للكنيسة ولشهادتها في العالم من النواحي الأنثروبولوجيّة والروحيّة واللاهوتيّة والأخلاقيّة، والتي تفرض على الكنيسة مواجهتها ضمن خلقٍ جديد واعٍ في الجماعة الكنسيّة شاهدةً لرسالتها. فما كان موقف الكنيسة الأرثوذكسيّة من التسارع الرقمي الذي أوجده انتشار فايروس كورونا؟ وهل يمكن لهذه الجائحة أن تكون بمثابة عاصفة تجديدٍ في الفكر الكنسيّ، وإعادة تحقيق العلاقة المتوازنة بين اللاهوت والعلم؟ لقد حلَّت جائحة كورونا على البشريّة حيث لم يكن العالم مستعداً أو جاهزاً لمواجهتها، وكان يتطلّب في وقته استجابة فورية ومنظّمة وخاصّة على مستوى النظام الصّحيّ العام. فجاءت الإرشادات والإجراءات الوقائية مع بدء انتشاره للحدّ وتقليص عدد المرضى والمصابين والموتى من جرائه. ومن تابع بموضوعية تعاطي الكنائس الأرثوذكسيّة مع جائحة كورونا سيخلص إلى الملاحظات التالية: أزمة إدارة "جائحة كورونا" لقد كانت استجابة الكنيسة للوباء بطيئةً للغاية، سواء كان من ناحية إصدار البيانات المتناسبة مع وزارة الصّحة العالميّة أو من ناحية تحضير الكهنة والتنظيم الكنسيّ على مستوى التكنولوجيا لواقع الكنيسة الرقمي. وهذه الوتيرة البطيئة جلبت، ومازالت، الكثير من الأخطاء، وأظهرت العجز والتخلف في بعض الممارسات والتصريحات من بعض الرعاة والكهنة أمام تطوّر العلوم الطبيّة والمخبريّة. إلاّ أنّه في نفس الوقت ظهرت مبادرات فرديّة من إكليريكيّين ولاهوتيّين ومؤمنين أخصّائيّن في تقديم الكثير من الحلول العلميّة والعمليّة واللاهوتيّة لمسائل ارتبطت بالأدوات الطقسيّة وضبط الأمور الرعائيّة، ولكنّها لم تؤخذ بعين الاعتبار، برغم مرور سنة حتى الآن، وهذا يعود إلى أنّ قيادات الكنيسة ومجامعها لا تريد إظهار الجديّة والمرونة وإظهار الشجاعة والتكيّف اللازم للتعاطي مع هذا الوباء الذي تحدّى العالم بأسره. إنّ جائحة فايروس كورونا- covid 19، ليسَ الجائحة العالميّة الأولى وليسَ الأخيرة التي تمرّ على البشرية. وللكنيسة أمثلة عمليّة كثيرة في تاريخها من الممكن استخلاصها والأخذ بمعطياتها الإيجابيّة لمساعدة الجماعة الكنسيّة في هذا المجتمع الكبير. في عصر الآباء، رؤساء الكهنة العظام: باسيليوس الكبير وغريغوريوس اللاهوتيّ ويوحنّا الذهبيّ الفمّ، كان أغلبية المؤمنين يؤمنون بالشفاء عن طريق الضرب البسيط على الرأس من قبل رجال الدين، أو من خلال تلاوة صلواتٍ وأدعية عامّة. لقد سادَ في ذلك الوقت التعصّب الأعمى. فالسِحر كان منتشراً في طبقات المجتمع المسيحيّ ككلّ، وكانت الرسوم الغامضة والأقوال والتمائم السحريّة لطرد الأرواح الشريرة قيد الاستعمال اليوميّ. فقد كانت حدود الإيمان عندهم تستند إلى قوة السِحْر وفعله. لذا أخذ الآباء يشدّدون من خلال أقوالهم ورعايتهم على قيمة العلوم وأهميتها وعلاقتها مع الإيمان. فباسيليوس الكبير، في كتابه الستة أيام- Η Εξαήμερος، كان يدافع عن ضرورة احترام العلوم الطبيّة، ويشدّد على أنّ أصله خيرٌ من الله نفسه. في حين أن الذهبيّ الفم كان يقول: "أنّ لولا خروج الإنسان من الفردوس لما كان من حاجة لوجود الأطباء. فالله أعطى الإنسان العقل المتجدّد بالعلم ليساعد الإنسانية جمعاء". وكثيراً ما كان يستخدم صوراً وأمثلة من الطبّ عندما كان يتكلّم عن القضايا والمسائل اللاهوتيّة. وبدوره، أيضا،ً غريغوريوس اللاهوتي كان يشدّد في نصوصه على نمط وأسلوب الأطباء الفعّال في معالجة المرضى حيث يقول: "على الطبيب أن يكون في حالة معنوية جيدة. فثقة المريض به وإظهار محبته من خلال اهتمامه به سيساعد كثيراً في تخفيف ألمه". الكنيسة والعالم الرقميّ لقد كشف الوباء حقيقة أننّا بحاجّة ماسّة إلى إعادة تحليل أمورٍ كنسيّة جديدة على ضوء القيود والإجراءات المفروضة كالمسافة الاجتماعية الآمنة والصّحة العامة. وبالتالي التجربة الرقمية الكنسيّة التي اتخذت في الكنائس، والتي ستستمر أيضاً لفترة أطول، ستؤثر على حضور الجماعة الكنسيّة في الكنيسة. أمّا آثار التكيّف مع الكنيسة الرقمية سيكون له رد فعل مؤلم ومعقد إن لم يُحتوى بشكلٍ يناسب خير وبنيان كلّ الكنيسة. ومن هنا، على القيادات الكنسيّة أن تتحمّل بشجاعة ردود الفعل المتطرفة بهذا الشأن، وتسعى منطلقة من أساسها اللاهوتي الجامع لإعادة ولادة روحيّة لطريقةٍ تفعّل فيها رسالة المسيح، وتكون فرصة لتجديد إنجيلي للتقنيات المستخدمة بحكمة ووعي وتعقلٍ. بالواقع، لقد أدخلنا التقنيات الحديثة في النطاق الكنسيّ، فكثير من الكنائس تستعمل أجهزة IPads لقراءة الرسائل والانجيل أثناء الخدمات الطقسية، وتستخدم أيضاً أجهزة الموبايلات في الأديار وأنشأت المواقع الألكترونية للأبرشيات والمدونات والقنوات التلفزيونية الدينية.. الخ. ولكن هنا نواجه شيئاً مختلفاً تماماً، إنّه تجربة كنسيّة إفخاريستية- رقمية، لا يمكننا معرفة الآثار طويلة الأمد وعواقب التطورات الرقمية التي نشهد تسارعها يومياً بسبب فايروس كورونا. ومن هنا، برأيي، أن هذا التسارع يفتح فرصاً للكنيسة لإعادة التبشير الكنسي في مجتمعٍ يتسم بتعددية العبادة المسيحية بطابع تنافسي رعائي. وهذا العالم الرقمي المفروض لتقليل المسافات الاجتماعية طبيعيٌ ويعطي راحة وأمان للعالم. وبالتالي السؤال اللاهوتي الذي يفرض نفسه هو: كيف يمكن أن يكون لدينا خدمة إفخاريستيّة مكتملة وموحدة دور مشاركة مكتظة من المؤمنين؟ وكيف نستطيع أن نفعّل دور الكهنوت الملوكي للمؤمنين في توزيع الإفخاريستيا الى جانب دور الكهنة؟ إنّه سؤال معقَد للغاية، وبالتالي جوابه لا يمكن أن يكون بردود فعلٍ أصولية متزمتة. فالعلاقة الكنسيّة- الرقمية سترافقنا طوال فترة الوباء وما بعده، لذا علينا أن نوازن في العلاقة هذه، ونبحث في تاريحنا الأرثوذكسي العظيم الغني عن حلولٍ لكي لا نضيّع هذه الفرصة التي تقوم على الصلاة والحكمة والنعمة الإلهية. العلاقة بين الإيمان والعلم وكشف التاريخ الأرثوذكسي إنّ معظم المسيحييّن الأرثوذكس في هذا العالم لا يعرفون تاريخهم، ولا نقدّر ثراء التاريخ والتقليد الأرثوذكسي. لقد فتحت لنا الجائحة ضرورة ملحّة لتطوير معرفتنا بالتاريخ الأرثوذكسيّ، هذا التاريخ الذي كانت فيه رؤية الكنيسة واضحة وموفقة في التوازن بين الإيمان والعلم. إنّ سوء الفهم الذي سادَ طوال فترة الجائحة لدى الكثير من رؤساء الكهنة والكهنة والمؤمنين من جميع الطبقات حول تلك العلاقة المعاكسة للإيمان والعلم بأنّ "للإيمان تأثير مباشر على معالجة الوباء"، وهذا بلا شكّ يتوجّب تصحيحه وذلك بالمشاركة المستمرة وفتح باب الحوار والنقاش مع لاهوتييّن ومختصّين في مجال الطبّ والصّحة العامّة. نحن ما زلنا نواجه وضعاً سريالياً حيث يرفض الكثير من الأرثوذكس (إكليروس ومؤمنون) حتّى مراعاة التدابير الوقائية اللازمة لحماية أنفسهم وحماية الآخرين من حولهم. ويرفضون ارتداء "الكمامة" حتّى في أقل الخدمات الكنسيّة عدداً كما في حفلات الزفاف وطقس المعمودية والجنازات. لا بل، أيضاً، يأخذون بانتقاد العلم ويعتبرونه، للأسف، عدواً للإيمان. هذه الفئة تعتبر أنّ الإيمان الأرثوذكسيّ هو بمثابة عبادة سِحرية، وهذا النهج يُصبح أكثر تطرفاً وأصولية عندما يتمّ ربطه دوماً بإيديولوجيات سياسية علمانية. هذه الظاهرة الأصولية لا علاقة لها نهائياً باللاهوت الأرثوذكسيّ، وتتجاهل بالكامل ما نؤمن به. فكلّ إنسان مخلوق على صورة الله ومثاله، ومسؤوليتنا الروحيّة واللاهوتيّة هي حماية إخوتنا من خلال تطبيق الإجراءات الوقائيّة المطلوبة. أمام الكنيسة فرصة إعادة توجيه الرعاة والرعية من خلال تربية سليمة توازن العلاقة ما بين الإيمان والعلم في محاربة الفايروس والأصولية والتطرف. فايروس الأصوليّة المسيحيّة كلّ نقاش تمّ خلال فترة الجائحة، على مدار السّنة، حول موضوع "الملعقة المشتركة" التي توزَع فيها "جسد المسيح ودمه الكريمَين" على المؤمنين بحسب الطقس الأرثوذكسيّ في سرّ الإفخاريستيا، عُبّر عنه بأكثر الطرق تطرفاً وأصولية، وأظهر الفقر التام والجهل بالمعرفة حول تاريخنا وتقليدنا الأرثوذكسيّ. وبالتالي، هذا الوباء يضعنا أمام فرصة النقد الذاتي لتحسين وتجديد التعليم الديني واللاهوتي للرعاة والكهنة والمؤمنين. وأيضاً، الاستفادة من العالم الرقمي وبرامجه بشكلٍ كبير لنقل تجارب وخبرات الأرثوذكسييّن ومعارفهم الطبيّة واللاهوتية بشكلٍ واسع وجديَ. ما معنى أن نكون "كنيسة" ونختبر ونعيش ما نُسمى عليه؟ من المهم أن نعتبر أنّ هذه الجائحة عاصفة ذات مغزى لتجديدٍ في كنائسنا، وتجديد الفهم القائم على العلاقة ما بين الإيمان والعلم. الكنيسة الأرثوذكسيّة في ركودٍ قاحل، فالعلم اللاهوتيّ المطروح لا يحمل في طياته توثيق موضوعيّ لهذه العلاقة التي يجب أن ترتقي من الحالة الإيمانية الإختبارية الشخصية للمؤمن إلى حالة أكثر جوهرية من حيث علاقته بالكنيسة، وإلاّ فتهميش الكنيسة الأرثوذكسيّة آتٍ لا محالة! لا يمكن للكنيسة أن تتجنب فتح النقاش والحوار حول المواضيع التي تطّرق لها الوباء، وهي تطوّر الأبحاث الطبيّة والعلوم الوراثية. أما حديث البعض عن أنّ اللقاحات تحوي أقراصاً معدنية تضعها شركات الأدوية لتغيير الحمض النووي DNA في الجسم وللتجسس عالمياً هو ضربٌ من الجنون! نقاشٌ شائن بالطبع لا يصلح إلاّ من خلال نظام تعليمي عفا عنه الزمان. هذه الطروحات لا علاقة لها باللاهوت والعبادة. هل طُرح موضوع علاقة اللاهوت بالطبّ في معاهد اللاهوت والإكليركيات أقلّه؟ إذا كان لا، فجدير بنا أن يكون هذا أول نقاش وحوار يُطرح حول: "الإيمان والعلم والمرض". أخيراً، نحن بحاجة لنهجٍ لاهوتي كبير، وإعادة ثقة المؤمنين بكنيستهم وعدم تضليلهم بمعلومات وفتاوى وتفاصيل دون رقابة علمية ولاهوتية. الحوار باتَ ضروري مع أصحاب الإختصاصات بكافة المجالات: الطبّ- علم الوراثة- علم البيئة والمناخ- علم اللاهوت. ونشره بكلٍ وعي ونضجٍ وصدقٍ وشجاعة. فالأرثوذكس ينبغي أن يكونوا حماة إيمان وعلمٍ وليسَ عِرقاً متفوقاً على الآخرين بسحرٍ أو عبادة غيبية.
0 Comments
إلى روح كلّ إنسان مات في سبيل كرامته البشريّة في سوريا ولبنان وكلّ مكان
خريستو المرّ الثلاثاء ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٢١ يعيش العالم العربيّ في ظلّ أنظمة استبدادٍ قائمةٍ على عبادة الشخص وفرض عبادته بالقوّة والخوف، أي بإرهاب الدولة لمواطنيها. في ظلّ هذا الوضع، كلمات مثل الجمهوريّة والملكيّة لا معنى لهما، فالأنظمة واحدة في الاستبداد المتحالف دائمًا مع الخارج. يبدأ الاستبداد في محو الآخر، شخص أو مجموعة تقمع الآخرين داخليّا وتبني لها شبكة مصالح مع طبقة اقتصاديّة، مستقويةً بذلك على المجتمع الأوسع. والاستبداد لبّه تأليه الذات، فكلّ الاستبدادات تصبّ في ديانة عبادة الشخص. تنتشر صور الزعيم الأوحد «المفدّى»، وتَزرع المدارسُ ووسائل الإعلام «محبّته» في برامج غسل أدمغة تُسبغ على الزعيم صفات غريبة عنه في الواقع. لكنّ عبادة الشخص هذه قهريّة، على عكس عبادة الله التي ترتكز في صفائها على الحرّية (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر). ويبلغ سعي المستبدّ إلى سرقة صفات الله أقصاه، بشكل مشوّه، حين تصبح كلمة المستبدّ مصدر موت للمعارضين، بحيث يتوهّم المستبدّ بقدرته على تدمير الحياة أنّ له قدرة مطلقة على شكل قدرة الله، لكنّ قدرة الله تخلق الحياة ولا يفهم ذلك القاتلون. وبينما قدّم «الراعي الصالح» نفسه مصلوبًا من أجل أحبّائه، يصلب المستبدّون مستعبَديهم ويذيقوهم ألون الذلّ والخوف؛ وما «المحبّة» الظاهرة للـ«قائد» المستبدّ سوى الوجه الآخر للخوف، والخوفُ يُبقي الإنسانَ تحت العبوديّة. وفي البلاد التي ينتشر فيها استبدادٌ واحدٌ برؤوس كثيرة، كلبنان، يجتمع المستبدّون على تغميس خُبزَ السلطة والمال بدماء القتلى، وإذا بالمستبدّين جَسَد أمير الموت لا جَسد ملك الحياة ذاك الجسد الذي يصيره المحبّون الذي يُحيُون الموتى من الفقر والعزلة والوحشيّة. وتتجلّى سيادةُ المستبدّين في جرائم متعدّدة في البيئة والاقتصاد وغيرها ولكن جريمتهم الكبرى هي تبرير الجريمة؛ فتُصوَّرُ الفاشيّة التي تفرض انصياعًا كاملًا للفرد أمام الجماعة وتنتقم من الاختلاف بالقتل وتلفظ التنوّع، أمرًا ضروريًّا من أجل ألف قضيّة وطنيّة؛ ويغدو القتل -المستسهلُ دائمًا- «أهون الشرّين» لأجل حياة «القضيّة» و«تطهير» البلاد من «الخونة». وبذلك تضمحلّ فكرة احترام الإنسان، واحترام الاختلاف الإنسانيّ الذي وحده يحفظ السلام الداخليّ في المجتمع ويفتح الباب أمام ابتكار الحلول، أي على كشف الأخطاء وتصحيحها. إيمانيّا اليوم، القضيّة الأخلاقيّة الكبرى هي أن يُبقي الإنسان في قلبه على سلامة الرؤية بحيث ينتفي من ذهنه تبرير الموبقات باسم الشعارات، فيعود إلى شفافيّة لبّ الرؤى الإنسانيّة المشتركة التي تجسّدها شرائع حقوق الناس، وأساسها احترام حقّ الحياة بكرامة. القضيّة الإيمانيّة الكبرى هي رفض عبادات أصنام قادة الموت، من أجل عبادة لله حقّة تتجسّد أكثر ما تتجسّد في حبّ وجه الإنسان الآخر وخدمة الحياة فيه. هذا كلّه مسيرةٌ إلى أمام للخروج من أسر أصنام المستبدّين، وهذه المسيرة هي خوف المستبّدين الكبير، فكمّهم للأفواه وحكمهم البوليسيّ يتصاعد كلّما تصاعد خوفهم من ترك السلطة والمال، من سقوطِ وهمِ تألّههم في عيون الناس. وفي مسيرة الناس نحو لفظ طبائع الاستبداد لا بدّ مِن التمسّك بالحرّية والعدل، فمَنْ خَرَقَ أحد هذين عاد لتوليد الاستبداد ورشّح نفسه صنمًا للعبادة. ولكن كيف يلحق الناسُ بالمستبدّين؟ طبائع الاستبداد لا تقول عن نفسها أنّها كذلك، هي تقول عن نفسها أنّها مصدر الحماية والرعاية والحكمة والأبوّة والنصر والقضايا، ولكنّك تُعرفُ من ثمرتها الأولى: الظلم. والقمع ظلم، والاعتقال ظلم، وإطلاق الرصاص على التظاهرات ظلم، والتهم الجاهزة بالخيانة ظلم، ونهب الناس ظُلم، ولا ترفع الظلم المساعدات العينيّة. إنّ طبائع الظلم هي الوجه الآخر لطبائع الاستبداد. والاستبداد كالعدوى ينشر نفسه في المجتمع ليدخل العائلة والمدرسة والجامعة والثقافة حيث تنتشر الصنميّة ويستقرّ الخضوع للصنم الأعلى، وتُدفَنُ الأفكار والممارسات ليس بقوّة الحوار والحجّة وإنّما بقوّة القمع الفاشيّ. ولهذا كان الحبّ بطبيعته المحترمة للتمايز والتعاطف والحرّية شهادة إيمانيّة كبرى، ولهذا يكره المستبدّون الحبّ أو يسخّفونه ويحاولون تهميشه كعاطفةٍ لا معنى لها أو رغبةٍ عابرة، ولا يرون فيه تجلٍّ لله ذاته كما تقول الخبرات الدينيّة والإنسانيّة في بهائها. ولهذا لا بدّ من إعادة اعتبار الحبّ كقيمة كبرى في وسطنا ليكون منارتنا في مسيرة التحرّر من الاستبداد. كلّ نضال لا يستند إلى المحبّة الإنسانيّة يتوه، كما دلّنا نحرُ الشعوب والقضايا الـمُحقّة على مذابح الأصنام. يأتي عيد الفصح بحسب التقويم الغربيّ هذه السنة مثقلاً بالالتباسات. لعلّ أبرز هذه الالتباسات يكمن في أنّ الجائحة ما زالت تتحكّم في واقع الناس، ما يجعلهم يترجّحون بين حنينهم إلى الأيّام التي كانوا قادرين فيها على أن يروا بعضهم بعضاً بلا خوف مفرط من انتشار الأوبئة والأمراض، وشعورهم بأنّهم بدأوا يتكيّفون شيئاً فشيئاً مع حياة من نوع آخر تحتلّ فيها الاجتماعات الرقميّة مساحةً كبيرة. غريب هذا الشعور، وغريب هو الإنسان. فهو من جهة يدرك أنّه «حيوان» اجتماعيّ، كما كتب أرسطو ذات يوم، وأنّ التواصل بالنسبة إليه ليس ترفاً، بل هو أشبه بالهواء الذي يتنفّسه. لكنّه من جهة أخرى يستشعر أيضاً في ذاته قدرته المذهلة على التكيّف، والتي ربّما تعكس ما ترسّب في سيكولوجيا الأفراد والجماعات من حكاية طويلة من التبدّل والتأقلم حاول العلماء تلمّس بعض جوانبها في ما يسمّونه «نظريّة النشوء والارتقاء».
بمعنى ما، سيبقى الالتباس التباساً. ثمّة مؤشّرات إلى أنّ البشريّة بدأت تستعدّ لخوض غمار هذا النوع من الحياة الهجينة، والتي تزاوج بين الاجتماع الحسّيّ والاجتماع الرقميّ، وذلك حتّى لو تسنّى لنا أن نكبح جماح الجائحة بفضل اللقاحات التي طوّرها العلماء بسرعة قياسيّة في عمليّة بحثيّة وإنتاجيّة لم تعرف البشريّة مثيلاً لها في تاريخها الحديث. ولكنّ حلول عيد الفصح للسنة الثانية على التوالي في هذه الأزمنة التي يغلب فيها الحذر على الثقة والشكّ على اليقين إنّما يضع نصب أعيننا حقيقةً لم نسائلها يوماً لفرط إدراكنا كم هي بديهيّة، حتّى أتت الجائحة كي تظهر لنا أنّ البديهيّ يمكنه أنّ يبدّل موقعه في لحظة وينتقل إلى خانة اللابديهيّ. هذه الحقيقة تتلخّص في أنّنا لسنا كائنات عقليّةً فحسب، بل نحن كائنات نحتاج إلى الحسّ، إلى مصافحة الآخرين واحتضان أصابعهم وضمّهم ومعانقتهم وتلقّف نبرة أصواتهم لا على جهاز الكمبيوتر أو على الهاتف الجوّال، بل وجهاً وجه. لا شيء يغني عن هذا الشعور، لا نقل الخدم الكنسيّة عبر الصفحات الرقميّة، ولا دعوةً الناس إلى استنباط طرق للتعييد في بيوتهم من دون الذهاب إلى الآخرين. فالعيد لا يقتحم حياتك ما لم تختبر تغيّر الأمكنة. والأمكنة هي الناس الذين يقطنونها. كما أنّ معمول العيد يشكّل طقساً فريداً من دونه لا يتّخذ العيد بعداً «تجسّدياً» في حاسّة الذوق، كذلك فإنّ الحجّ إلى الوجوه في العيد، واقتران هذا كلّه بطقوسيّات لا تأتي إليك ما لم تذهب أنت إليها، ليس تفصيلاً، بل هو جزء لا يتجزّأ من المعنى الجديد الذي يسبغه العيد على تفاصيل حياتنا. في مثل هذه الأيّام من السنة الماضية، كنّا تحاول إقناع ذواتنا بأنّ الجائحة مجرّد غيمة صيف، وأنّها ستنقضي سريعاً. اليوم ندرك أنّنا ربّما غالينا في التفاؤل. فلا أحد يستطيع أن يتكهّن بما ستكون عليه الأمور في السنة المقبلة، لا العلماء ولا السياسيّون ولا ضاربو المندل. ولكنّ الخطورة هي أن نتعوّد على فائض الفردانيّة الذي فرضته علينا الجائحة فنتحوّل إلى بشرُ أقلّ إنسانيّةً وأكثر تعاسة. وهذه الحال لا ينفع معها لقاح كائناً ما كان مصدره. عيد الفصح يأتي اليوم كي يذكّرنا بأنّ الاجتماع الأصيل مرتبط بالحسّ وبأنّ العقل، كما أنّه مطالب بعدم الانفصال عن القلب، هو أيضاً مطالب بعدم الوقوع في محظور الانفصال عن الجسد. فالتواصل مع الآخرين يحتاج إلى الجسد كما تحتاج الخمر إلى وعاء كي تصبح قابلةً للتذوّق. إنّ بعضاً من خمرة العيد هو وجوه الآخرين الذين «في عيونهم ومضة إذا هم أبصرونا» (جورج خضر). عسى تكون الخوابي مثقلةً بالوجوه في العيد المقبل... أسعد قطّان |
Telosقضايا حاليّة أرشيف
|
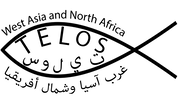

 RSS Feed
RSS Feed