|
كتب أسعد قطّان:
إلى الصديقة ل. ي. قضيّة الفتاة المصريّة سارة حجازي، التي جاهرت بمثليّتها الجنسيّة وانتحرت قبل أيّام، أعادت طرح مسألة الإصلاح الدينيّ بقوّة. هل الإصلاح الدينيّ ممكن؟ علينا، بادئ ذي بدء، أن ننتبه إلى المصطلحات التي نستخدمها. لفظ «إصلاح» في اللغة العربيّة ليس محايداً، بل ينطوي على مخزون دلاليّ سلبيّ. أنت تقوم بإصلاح الشيء لكونه أضحى غير صالحٍ، أو ضارّ، أو تشوبه علّة ما. هذا الظلّ السلبيّ في المعنى لا يلتصق باللفظ المستخدم في معظم اللغات الأوروبيّة. فكلمة reform، من حيث جذرها اللغويّ، تحيلنا إلى مجرّد إعطاء شكل جديد أو شكل آخر. الشكل القديم ربّما يكون سيئاً، ولكنّه ليس كذلك بالضرورة. هذا من حيث المصطلح. بيد أنّ التبصّر في شؤون الدين وشجونه يتخطّى المصطلحات والإشكاليّات التي تحيق بالمصطلح. خطورة الدعوة إلى «التصرّف» بالدين هو ما يلتصق به من مخزون سيكولوجيّ. أذكر أنّ هذه المركّبة السيكولوجيّة تبدّت لي بوضوح في أحد المؤتمرات التي انعقدت في تونس بعد ربيعها العربيّ. آنذاك، قال أحد الأصدقاء، وهو من فلسطين، ما معناه أنّ عبارة «الإسلام جيّد والمسلمون سيّئون» لا تزعج أحداً في الشرق فيما هي تُعتبر امتهاناً للكرامة الإنسانيّة في الغرب. بالمقابل، عبارة «الإسلام سيّء والمسلمون صالحون» غالباً ما تستفزّ المسلمين في بلادنا وتحدوهم على النزول إلى الشارع للتظاهر فيما هي تكاد لا تثير أحداً في الغرب. القضيّة هنا ليست مجرّد مفهوم الدين بين مجتمعات شكّلتها الحداثة الغربيّة ومجتمعات لم تتمثّل الحداثة إلاّ جزئيّاً، بل القضيّة أيضاً هي أنّ الدين يضرب جذوره عميقاً في تربتنا السيكولوجيّة، ما يجعل الدعوة إلى «إصلاحه» أمراً إشكاليّاً. ترتبط مسألة الإصلاح الدينيّ بقضيّة جوهريّة تتلخّص في السؤال عن الثابت والمتحوّل في كلّ دين من الأديان والعلاقة بينهما. بعبارات أخرى: من يؤمن بضرورة الإصلاح الدينيّ هو من يوسّع رقعة المتحوّل في الدين ويضيّق رقعة الثابت. بخلاف ذلك، من لا يستسيغ الإصلاح الدينيّ، أو يرفضه، هو من يوسّع رقعة الثابت في الدين ويضيّق رقعة المتحوّل، أو حتّى ينكرها. طبعاً، الدراسة التاريخيّة الرصينة تبيّن أنّ الأديان شهدت عبر العصور تغيّرات جمّة وتحوّلات جذريّة. هذا في طبيعة الأشياء الواقعة في مجرى الزمان والمكان. فالأشياء التي لا تتبدّل لا تستطيع أن تستمرّ. والدين يسعى بطبيعة الحال إلى الاستمرار. ولكنّ رافضي فكرة التحوّل في الأديان لا يكترثون في غالبيّتهم للدراسة التاريخيّة. فالدين عندهم غالباً ما يحيلنا لا إلى الواقع التاريخيّ القابل للتحليل والتشريح، بل إلى المتخيَّل، وإلى حيّز مثاليّ لا علاقة له بالشرط التاريخيّ ولا بعلوم التاريخ. من الصعب على الذين يتشبثّون بالدين في صيغته المتخيَّلة، ويسبغون عليه صفة عدم التحوّل، أن يقتنعوا بفكرة الإصلاح الدينيّ. والحقّ أنّ هذا الإصلاح كان في غالبيّة الأحيان (ولكن ليس دائماً) وليد عوامل فرضت ذاتها على الدين وأهله من «الخارج»، إذا جاز التعبير، ولم يأتِ نتيجةً لديناميّات دينيّة «داخليّة»، علماً بأنّ التمييز بين الخارج والداخل هنا له طبعاً حدوده ومحاذيره. وربّما يكون الاستثناء الأكبر من هذه «القاعدة» هو حركة الإصلاح البروتستانتيّ، التي انطلقت من رحم الكنيسة الكاثوليكيّة، وذلك من دون التقليل من شأن عوامل خارجيّة كالحركة الإنسانويّة واختراع الطباعة. التحدّي الأوّل للدين كان الفلسفة. الفلسفة صنو العقل البشريّ الذي يسمح لذاته أن يسائل كلّ شيء ولا يرتضي بأيّ حدود لحرّيّته في التفحّص الفكريّ. الفلسفة اليونانيّة القديمة، مثلاً، منذ هيراقليط راحت تسائل المنظومة الدينيّة اليونانيّة التقليديّة وتضطرّ القائلين بها إلى تشذيب قناعاتهم أو تغييرها. سلطة العقل هذه تكثّفت في العلوم. لم ينجُ عصر من العصور من الصراع بين العلم والدين منذ أرسطو مروراً بالرازي وابن سينا وصولاً إلى الحداثة. ولكنّ تحدّي العلوم للدين تكثّف في الأزمنة الحديثة، وتخطّى نطاق العلوم التجريبيّة كالطبّ والفيزياء. ولا أخالني مخطئاً في الاعتبار أنّ أبرز ما اضطرّ أهل الدين إلى إعادة النظر في عماراتهم العقائديّة كان في القرنين الأخيرين، إلى جانب العلوم التجريبيّة، دخول العلوم الإنسانيّة، كالتاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس، على خطّ مساءلة الثابت في الدين. من الممكن أن تجد عالماً تجريبيّاً لامعاً يتعامل مع المنظومة الدينيّة التقليديّة بكلّ سذاجة. الكاتب فرج فودة يروي، مثلاً، في إحدى مقالاته كيف أنّ طالبةً في السنة الخامسة من دراسة الطبّ سألت ذات مرّة أحد شيوخ الإسلام إذا كان الشرع يسمح لها بأن تخلع ثيابها أمام كلب ذكر. هذا الفصام بين العقل والدين ممكن طبعاً لدى الذين حفرت عقولهم العلوم الإنسانيّة أيضاً. ولكنّه هناك أكثر ندرةً في تقديري. العامل الثالث الذي يفضي إلى مراجعة الثابت الدينيّ من خارج الفلسفة والعلوم يمكن أن نضفي عليه تسمية «المعطى الأخلاقيّ». قد تبدو هذه الملاحظة غرائبيّة. هل هناك أخلاق من خارج الدين؟ أليست الأديان هي مربض خيل التنظير الأخلاقيّ؟ لسنا هنا في صدد تقصّي العلاقة بين الدين والأخلاق. نكتفي بالإشارة إلى أنّ هناك مسلّمات أخلاقيّة حازت على إجماع البشر، أو شبه إجماعهم، بفعل التجربة التاريخيّة، وهي ما زالت تضطلع حتّى اليوم بوظيفة مساءلة الأديان ودعوتها إلى إعادة النظر في العلاقة بين الثابت والمتحوّل في تراثاتها. هذه المسلّمات ربّما تكون في منشأها ذات أصول دينيّة. ولكنّ هذا لا يضعف من قدرتها على خلخلة العناصر التي تدافع عنها المؤسّسات الدينيّة بوصفها ثوابت. من وجهة نظر تاريخيّة، يمكن، مثلاً، اعتبار توصّل البشريّة إلى الإقرار بأنّ مؤسّسة العبوديّة تتعارض مع إنسانيّة الإنسان واحدةً من هذه المسلّمات الأخلاقيّة. من المعروف أنّ فكرة المساواة بين البشر لها أصول في الأديان، ولا سيّما في اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام. غير أنّ هذه الأديان لم تنجح تاريخيّاً في نبذ العبوديّة والقبول بإرسائها اجتماعيّاً لو لم تتلقّ دفعاً قويّاً من «خارج» الدين، إذا جاز القول. في زمننا الحاضر، تمارس شرعة حقوق الإنسان هذا الدور. فهي تقرع باب الأديان وتدعوها، بقوّة الخبرة الإنسانيّة التراكميّة، إلى مراجعة دائمة للعلاقة بين الثابت والمتحوّل في عماراتها الفكريّة والعقائديّة. شخصيّاً، أنا مقتنع بأنّ شرعة حقوق الإنسان ليست غريبةً عمّا ترسّب عبر العصور في الجماعات البشريّة من وعي يتّصل اتّصالاً مباشراً بالدين. ولكنّ هذا لا يجعلها أقلّ قدرةً على تفكيك ما يتمسّك به اليوم بعض أهل الدين على أنّه ثابت «دينيّ» لا يتغيّر، وذلك لأسباب ليست لاهوتيّة بالضرورة، بل غالباً ما تكون مرآة لتراكمات جمعيّة أو تهويمات سيكولوجيّة أو مشاريع سلطويّة. ربّما ينبغي لنا اليوم تدبّر مسألة المثليّة الجنسيّة من هذه الزاوية الأخيرة، أي من باب ما يتفجّر في المجتمعات من آفاق أخلاقيّة جديدة بفعل الحفر التاريخيّ وتراكم الخبرة ونمو الوعي، بالإضافة إلى المعارف التي يمكننا أن نجنيها من الطبّ والعلوم الطبيّة والأنثروبولوجيا، وذلك عوضاً من الاعتبار أنّ المعركة هي بين «أقلّيّة» تسلك سلوكاً جنسيّاً «بخلاف الطبيعة» ومنظومة دينيّة ثابتة لا تتغيّر. فهذا النوع من الاستقطاب لا يفضي غالباً سوى إلى مزيد من الضغط والترهيب والانكماش - وذلك حتّى لا نجد أنفسنا ذات يوم في متاهة الشعور بالذنب وشبح سارة حجازي المكسور بالقمع يطاردنا من مكان إلى آخر... حتّى آخر المعمورة.
0 Comments
كتب أسعد قطّان:
شخصيّاً أنا ممتن كلّ الامتنان لظاهرة الوباء، ولفيروس كورونا بالذات. إنّه الشعرة التي قصمت ظهر البعير كما قالت العرب. وإنّه الظاهرة التي أظهرت بما لا يقبل الجدل كمّ أنّ القيادة الكنسيّة في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأنطاكيّة مضعضعة ومتردّدة. لقد فهمنا الدرس جيّداً واستوعبناه وبتنا قادرين أن نعلّمه لأجيالنا المقبلة لمئات من السنين. فشكراً أيّها الفيروس العظيم. ألا بارك الله فيك. لقد كنت قادراً أن تبيّن في مسافة أسابيع ما كانت قياداتنا الكنسيّة تسعى إلى التستّر عليه وإخفائه طوال سنين. في أزمنة صعود وتيرة الوباء، من المنطقيّ والمقبول كنسيّاً ورعائيّاً أن تُقفل الكنائس لبرهة وأن يضطرّ شعب الله المؤمن إلى الامتناع عن المناولة المقدّسة. فالأولويّة هنا هي لحماية البشر وحماية صحّتهم. والنقاش حول ما إذا كانت طريقة المناولة المقدّسة تسمح بانتقال المرض إلى المتناولين أو تمنعه، رغم أهمّيّته، كان يختزن جانباً عقيماً. فلا أحد لديه استعداد ليضع المتناولين والمناولة المقدّسة تحت مجهر الاختبار العلميّ. ولا أحد، إذا كان متعقّلاً، يجرّب الربّ الإله ويطالبه بعجيبة هنا وعجيبة هناك. «لا تجرّب الربّ إلهك»، كلمات يسوع للشيطان نسيها معظمنا في أزمنة الكورونا. أمّا الآن وقد سُمح بفتح الكنائس وإقامة الصلوات والقدّاس الإلهيّ ضمن ضوابط مقبولة، فلا سبب يستوجب حرمان الشعب من المناولة الإلهيّة. الإجراءات التي فُرضت هنا وهناك، في الكنيسة الأنطاكيّة وخارجها، ولا سيّما في بعض بلاد المهجر، وقضت بالاحتفال بالليتورجيا الإلهيّة والامتناع عن مناولة الشعب تفتقر إلى المستند اللاهوتيّ والليتورجيّ. هي، بكلّ بساطة، إجراءات لا أساس لها في التراث وفي نصّ القدّاس الإلهيّ ذاته ولا يمكن تبريرها لا عبر الاستنجاد بالأزمنة التي كان الناس يتناولون فيها أربع مرّات في السنة، ولا عبر القول إنّ تعليمات الحكومات وصحّة المؤمنين تقتضي ذلك. ما نعيشه في الأمكنة التي تلجأ إلى هذه الممارسة هو في نهاية المطاف تقويض لسرّ الشكر الإلهيّ، وتالياً لسرّ الكنيسة التي تقوم عليه، كما تعلّمنا من الكتاب المقدّس والتراث الأصيل واللاهوتيّين المعاصرين الذين أعادوا اكتشاف تأصّل الكنيسة في سرّ الإفخارستيّا. طبعاً الإبقاء على شكل المناولة الحاليّ بالمطلق، أي التناول من الكأس الواحدة بملعقة واحدة، لا يقدّم حلاًّ، لأنّ ثمّة أناساً «ضعفاء» يخافون من التقدّم. ما العمل؟ الحلّ هو في استنباط شكل آخر بالإضافة إلى الشكل التقليديّ. وثمّة أمثلة في الكنيسة الأرثوذكسيّة يمكن استلهامها والاستفادة منها. طبعاً أنا أتفهّم موقف المطارنة في حيرتهم. هم واقعون بين مطرقة التدابير الصحّيّة وسندان امتناع المجمع الأنطاكيّ المقدّس عن بحث الموضوع. الثابت أنّ المطارنة أسياد قرارهم في أبرشيّاتهم. وموضوع شكل المناولة ليست مسألةً عقائديّة، وهم يستطيعون الاستعانة بطرق أخرى من دون العودة إلى المجمع المقدّس. ولكنّي طبعاً أفهم انتباههم إلى الوحدة وسعيهم إلى أن تكون الأمور بلياقة وترتيب. ولكنّ المشكلة في هذا المنطق أنّ سرّ الكنيسة، وتالياً وحدتها، معرّض للنسف بالامتناع عن مناولة الشعب. وهذه هي المفارقة التي يضعنا الوضع الحاليّ في مواجهتها. ضعضعة القيادة الكنسيّة وتردّدها يقومان في تخاذل المجمع الأنطاكيّ المقدّس، وفي إحجامه عن إقرار شكل آخر للمناولة على وجه السرعة يتناسب مع الأزمة الحاليّة. لو قام المجمع بهذا بصوت واحد وكلمة واحدة، لوفّر علينا الإمعان في ما نحن عليه اليوم من وضع شاذّ لاهوتيّاُ ورعائيّاً، ولحقّق رغبةً عُبّر عنها بصراحة في اللقاء الأنطاكيّ الموسّع الذي انعقد في البلمند العام ١٩٩٣. بين العام ١٩٩٣ والعام ٢٠٢٠ سبع وعشرون سنة. تغيّرت أمور كثيرة منذ ذلك الحين. اخترع العالم الإنترنت والموبايل واكتشف أدويةً للإيدز ولكثير من الحالات السرطانيّة. فهل يوجد مبرّر أن تبقى القيادات الكنسيّة تتحرّك على وقع السلاحف وكأنّها تعيش على كوكب آخر؟ (الأيقونة: تفصيل من تكثير الخبرات الخمس، متحف كوليمباري، كريت) |
Telosقضايا حاليّة أرشيف
|
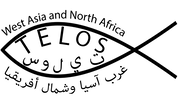

 RSS Feed
RSS Feed