|
ماريَّا قباره
الثلاثاء ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٠ احتاجت طقوس العبادة في إسرائيل وقتاً لتنتقل من البدائية إلى مراحل متطوّرة. فكان كلّ الأفراد- الذكور- قبل النظام الموسوي، يقدّمون الذبائح شخصيّاً إلى يهوه (سفر التكوين 4:4)، ويقيمون المذابح على اسمه ويكرّسون له المكان، فيصبح مقدّساً. وصار رؤساء البيوت والقبائل يمارسون الكهنوت من الأب إلى ابنه البكر. وفيما بعد، سنَّ موسى نظام جديد، ونشأ كهنوت "محترف" في قبيلة لاوي لم تنحصر مهمته في تقديم الذبائح وإقامة احتفالات الطقوس فقط، بل في تعليم وتفسير الناموس للشعب ونقل جواب الله إليهم. وقد تحدّدت وتوضّحت طقوس شعب إسرائيل أكثر، وأُعدَّ فيها نظام طقسيّ على أسس لاهوتية متكاملة بعد أن بنى سليمان هيكل أورشليم. يكفي لمعرفة ذلك قراءة الإصحاحات التالية من سفر الخروج 30:28، وسفر الأخبار الثاني 35، وبعض الإصحاحات من سفر العدد. خضّعت العبادة اللاويّة لمفهوم "الوساطة". فوجود الكهنة أمرٌ ضروري لحفظ علاقة مستمرة لإسرائيل مع الله، وكممّثل للشعب أمامه. فلا تعترف العبادة اللاويّة بإمكانيّة الفرد أو الجماعة بدخول علاقة مباشرة مع الله أو حتّى الصلاة إليه وقبول بركته. فمبدأ الوساطة متوائم مع مبدأ الفرز ويفرضه. فالعبادة غير ممكنة إلاّ بتدّخل أشخاص مفروزين من الكهنة. وتقوم هذه العبادة في أماكن مكرّسة منفصلة كالهياكل، ضمن أعياد واحتفالات وحركات طقسية مقدّسة. ويستبعد هذا الانفصال كلّ الاشخاص والأماكن والأزمنة الدنيوية. "فالدنيوية" هنا تشكّل عائقاً في اللقاء العبادي لله. وبالتالي، يصبح الكهنة أشخاصاً من نوع آخر، أرفع من عامة الشعب. والهياكل ليست كسائر الأماكن لأنّها باتت مطبوعة بوسمٍ إلهي لا يُمس تحت طائلة تدنيس المقدسات. يسوع المسيح "العلمانيّ" في العهد القديم كان يقصد بلقب "كهنة" في صيغة الجمع اللاويّون وفي بعض الأحيان الكهّان الوثنيون. لم تعرف الأناجيل أي تقليد يصوّر يسوع في مسيرته البشاريّة في ثيابٍ كهنوتية. وتخبرنا الإصحاحات أنّ يسوع دخل إلى رواق الهيكل وليس إلى الهيكل أو قدس الأقداس. ولم يسمَّ فيها "كاهناً" بالمطلق في العهد الجديد باستثناء الرسالة إلى العبرانيّين التي تشير إلى الربّ يسوع المسيح نفسه، الذي غدا "الكاهن الوحيد" أيّ الوسيط الوحيد بين الله والبشر، فكان بذلك تمام الكهنوت. كانت الجماعة الأولى تدعو لها "شيوخاً، شمامسة، مراقبون" لم تدعو لها على الإطلاق "كهنة". ولفظة "جماعة كهنوتية" التي وردت في رسالة بطرس الأولى (2: 5-9) كما في سفر الرؤيا (1: 6، 5: 10، 20: 6)، تشير إلى جماعة المسيحييّن، وليس إلى فئة مفروزة ومختصّة بالعبادة. والتعابير: كهنوت- عبادة- تقدمة- هيكل، المستخدمة في إصحاحات العهد الجديد لا تعني عبادة منفصلة عن العالم الدنيوي، بل عبادة متجذرة في يسوع ذاته وفي كيان جموع المسيحييّن، كيان في التاريخ وكيان في العالم. وهذه التعابير استخدمت في الرسالة إلى العبرانيين كنعتٍ لموت المسيح على الصليب. وبولس الرسول نفسه يؤكّد على أنّه قام بعملٍ كهنوتي حين أعلن البشرى الجديدة للوثنييّن الذين بالإيمان أصبحوا تقدمة مقبولة مقدّسة بالروح القدس (رومية 16:15). وفي رسالته إلى أهل أفسس يشير إلى أنّ الهيكل المقدس هو كنيسة المسيح الجامعة (12:2). نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين "واضحٌ أَنَّ ربَّنا قد طلع من سبط يهوذا، الّذي لم يتكلَّم عَنهُ موسَى شَيئًا مِنْ جهة الكهنوت" (14:7)، وهذا برهان قاطع يُبعد كلّ أصلٍ كهنوتي عن يسوع. على عكس يوحنا المعمدان، ابن الكاهن الشيخ زكريا، الذي كان ينتمي إلى قبيلة لاوي والتي يخرج منها الكهنة بالتوارث. فيسوع المسيح كان "علمانياً"، إنّ صحّ التعبير، في المجتمع اليهودي المعاصر له. وموته على الصليب كان الحدث النقيض للمقدسات إلى أبعد حدود النقض. فالمسيح المصلوب من فئة اللصوص. وعلاوة على ذلك، بالنسبة للمجتمع اليهودي، فالصليب علامة للّعنة الإلهية "لأنّ المعلّق لعنة من الله" (تثنية الاشتراع 23: 21). العبادة بيسوع المسيح إنّ يسوع المسيح، ليلة موته، احتفل مع تلاميذه بطقس الخبز والخمر إعلاناً منه بموته ذبيحة على الصليب. وهذا معنى الكلمات التي قالها ليلة العشاء السريّ عند تكسير الخبز وتوزيعه كما وتوزيع كأس الخمر: "هذا هو جسدي المقدّم من أجلكم... هذا هو دمي المهراق من أجلكم.." (لوقا 9:22-22). فالعشاء الأخير مرتبط ارتباطاً مباشراً بذبيحة يسوع على الصليب. بمعنى آخر، العبارة الطقسية ترتكز على الاحتفال بالحياة. يعيش المؤمنون الليتورجيا بطريقة رمزية وشعرية، عبادة دنيوية زمنية. إنّ عبادة المؤمنين بيسوع المسيح مؤسسة على عبادة حياة المسيح، وكليهما محتفل بهما طقسياً ورمزياً وشعرياً في الليتورجيا، وهذا ما يؤكدّه بولس الرسول في رسالته إلى رومية: "بالموت يصبح المؤمن شريكاً في موت المسيح وقيامته فيموت عن الخطيئة ويحيا حياة جديدة". يعرَّف عشاء المسيح بوضوح على أنّه ذكرى موته ومشاركة في قيامته بانتظار مجيئه الممجّد (1 كور 11: 26). ومن هنا الكهنوت المشترك بين جميع المسيحييّن هو الملوكي والأولي في الكنيسة. هو الكهنوت الأعظم. لا كهنوت آخر يفوقه، فهو يتخطى كلّ الخدمات الطقسيّة والرتب والمناصب. الجماعة المسيحيّة في العهد الجديد والكنيسة اليوم نقرأ في رسالة القدّيس بولس الرسول الأولى إلى تلميذه ثيموثاوس عن المؤهلات الروحيّة لمن يريد أن يخدم الجماعة المسيحيّة، ويكون مضطلعاً بمسؤولية عن الرعاية والتعليم وغيرها من الأمور الداخليّة الخاصّة بتنظيم الجماعة المسيحيّة الأولى (1 تيموثاوس 3). لم يذكر بولس الرسول أو غيره من الرسل والتلاميذ شيئًا عن سرّ الكهنوت أو نظام الكهنوت الحالي الممارس في معظم الكنائس المسيحيّة. ولم يُلّقبوا أنفسهم بالبطاركة أو الأساقفة أو البابوات. نقرأ عن أول اجتماع أو "مجمع" لجماعة المؤمنين في الكنيسة الأولى لمعالجة مشكلة ختان غير اليهود: "رتَّبوا أن يصعد بولسُ وبرنابا وأُناسٌ آخرونَ منْهُم إلَى الرُّسُل والمشايخ إلَى أُورشليمَ" (أعمال الرسل15: 2)، "ولمّا حضروا إلى أورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ" (أع 15: 4). نلاحظ تكرار عبارة "الكنيسة والرسل والمشايخ" تأكيداً على وحدانية التعليم المسيحيّ، ووحدانية نموذج المعلّم يسوع المسيح رأس الكنيسة. لم يكن هناك قائدٌ للجماعة بمعنى الأُسقف اليوم أو البابا، بل كانت الكنيسة، أي جماعة المؤمنين، يتخذون القرارات جماعية. فالشيخ مدبرٌّ ومشرف، والشمّاس خادمٌ. وتلك الترتيبات كانت ضمن مبادئ احتاجتها الجماعة المسيحيّة الأولى لتنظيم نفسها، والعناية بأفرادها. في عهد المسيح أفرطَ الفريسيّون كثيراً في ابتكار عقائد وتقاليد وقوانين مختلفة لذا قال لهم المسيح: "أبطلتم وصيّة الله بسبب تقليدكم، يا مراؤون حسناً تنبّأ عنكم إشعياء قائلاً: يقترب إليّ هذا الشعب بفمه، ويكرمنّي بشفتيه، وأما قلبه فمبتعدٌ عنّي بعيداً. وباطلاً يعبدوني وهم يعلّمون تعاليم هي وصايا الناس" (متى 15: 6-9). فهل عادت الفريسيّة لتظهر من جديد اليوم، وتتسلّل إلى الكنيسة نفسها؟ أين كنيسة المسيح، الكائن الحيّ الذي ينمو بماء الروح القدس والحياة الأبدية التي بيسوع المسيح فتظهر ثمارها تلقائياً؟ أين هذه الكنيسة الحيّة المشتعلة بالروح القدس؟ لماذا اختفت ثمار ومواهب الروح القدس في العبادة المسيحيّة وحلّت مكانها طقوس جافّة ثابتة وشعائر دينية مبتكرة، أَلِضمان الفاعليّة والتأثير الشعبي؟ لقد عادت وظهرت الوساطة من جديد بين المسيحيّين والمسيح بواسطة الكهنوت المحترف. وقد أعيد تفسير وقراءة كثير من الأحداث التي مرّ بها التلاميذ مع المسيح على أنّهم ممثلون للكهنة فقط وليس للكنيسة كلّها وبهذا هُمِّشَ الكهنوت الملوكي؛ كهنوت جميع المؤمنين. في العهد الجديد صرنا كلّنا في المسيح ملوكاً وكهنة للآب "وجعلنا ملوكاً وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. آمين" (سفر الرؤيا 6:1). هذا بعد أن كان الكهنوت والنبوّة حكراً على فئة خاصّة من اليهود في العهد القديم لهم مسحة الدهن كرمز للروح القدس، وينتخبون من سبطٍ ونسل مُعَيَّنَيْن "وتمسح هارون وبنيه وتقدسهم ليَكْهَنُوا لي" (سفر الخروج 30: 30). وبعد انتهاء العصر المسيحي الأول وظهور الفلسفة اليونانية التي أثرت بشكلٍ كبير على تعاليم ومعتقدات المسيحييّن آنذاك باعتبارهم أقلّية وسط الشعوب الوثنية، تأثّر المؤمنين الجدد بمجتمعاتهم الدينيّة. وكان للإمبراطور الكبير قسطنطين التأثير الأكبر على الكنيسة، فقد ساهم في إدخال مظاهر العبادة الوثنيّة والطقوس الشكليّة إلى العبادة المسيحيّة، فقام ببناء الهياكل المسيحيّة الضخمة والفخمة للمسيحييّن وتمّ تزيينها في عصره بتماثيل تمثّل آلهة وثنيين. وبالرغم من أنّ عصر الإمبراطور قسطنطين كان راحة واستقراراً من الاضطهاد، فإنّه كان له في نفس الوقت سلبياته، ومنها تحويل الكنيسة إلى مؤسسة رومانيّة. فتحوّلت المسيحية إلى مصدر إقبال للكثير من الوثنييّن الذين رغبوا باعتناق دين الإمبراطور، فأصبحوا مسيحيّين بالاسم، وهذا التأثير ما زلنا نجني ثماره حتى اليوم. ومن ضمن تأثيرات الملك قسطنطين على الكنيسة تحويل وظائف الرعاة إلى مناصب دينية رسميّة تحت رعاية الامبراطورية الرومانيّة، فأصبح لهم ملابس خاصة، ورواتب، وامتيازات كالإعفاء من الضريبة والإعفاء من الالتحاق بخدمة الجيش الرومانيّ. تدريجياً، تحوّلت الكنيسة إلى مؤسسة أكثر دنيوية وأقل حيويّة. وما حضور الامبرطور في مجمع نيقيّة، برأيي، وهذا ما يتجاهله الكثير من المسيحيّين، إلاّ ليحافظ على مملكته من الانشقاقات. وهكذا، وبمرور الوقت، طوّر القادة الدينيّون نسج ورسم شخصيّاتهم الدينيّة والتي أصبح لها نظامها الخاصّ وملابسها المميزة. فاستعاروا الكثير من العادات المتّبعة والرموز الوثنيّة الشائعة في عصور المسيحيّة الأولى كاستعمال الماء المقدّس في التطهير والتقديس، والبخور والشموع في الطقوس....الخ. وأضفوا على مناصبهم كهيئات دينيّة الأسماء اليونانيّة: كالشمّاس والأسقف ورئيس الأساقفة والبطريرك، والبابا، وطوّروا منها وظائفهم. في رسالة بطرس الرسول الأولى نقرأ: " أطلبُ إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ رفيقكم.." (بط 5: 1). نعود لنقول، أنّ لا فرد واحدٌ متسلطٌ في الجماعة الأولى، فقد أشار بطرس الرسول إلى نفسه على أنّه رفيقهم في الخدمة، وليس باعتباره رئيس كهنة أو أسقف أو حتى قائد للرسل. وقد وضعنا يسوع المسيح أمام القاعدة الذهبيّة بقوله: "وأمّا أنتم فلا تُدْعَوا سيدي، لأنّ معلمكم واحد المسيح، وأنتم جميعاً إخوة. ولا تدعوا لكم أباً على الأرض، لأنّ أباكم واحد الذي في السّموات" (متى 23: 8-9). لذا نجد أنفسنا اليوم متأمّلين السّلطات الدينيّة ومدى مطابقتها لكلام الإنجيل ومسيرة يسوع المسيح الذي يقول: "أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف" (يوحنّا 10: 11). تحتاج الحياة المسيحيّة اليوم إلى إصلاح نفسها لتكون نموذجاً انجيليّاً ناظرة إلى نور المسيح وليسَ إلى سلطان العالم. فالرعاية ليست سلطان، والخدمة ليست تسلّطًا، والشركة ليست طقسًا، والروح القدس ليس زيتًا. فعبادة المسيح والمسيحييّن ميثاق تضامن وليس موقف فرز. لا نستطيع أن نكون أسيري العادات والأفكار القديمة وإلاّ سنكون عرضة لسخرية الآخرين، ومعزولين بإرادتنا عن المحيط والمجتمع. بل علينا أن نقرأ ونبحث ونخرج عن العادة والمألوف وننتج أساليب غير تقليدية للعمل والفكر ضمن إيماننا واعتقادنا بحسب فكر يسوع المسيح الخلاصيّ.
1 Comment
كتب أسعد قطّان:
تنبسط القارّة القديمة على جمالها الذي لا يشبه إلاّ ذاته ولا يُنسب سوى إلى ذاته. تنبسط القارّة القديمة على مجاز شكسبير وصرامة إيمانويل كانط في عمارته الفكريّة وروح الشرائع في فلسفة التشريع لدى مونتيسكيو. منذ أكثر من ستّين سنة وهذه القارّة تقدّم للمسلمين الذين أتوها أفضل ما عندها، وهو ما لا تقدّمه لهم غالبيّة المجتمعات التي كانوا ينتسبون إليها والتي نسمّيها «إسلاميّة». تقدّم لهم أوروبّا شيئاً من الرخاء الاقتصاديّ وكثيراً من العدل الاجتماعيّ فيما معظم المجتمعات الإسلاميّة ما زالت تشهد، سواء في القوانين أو في الممارسة، تمييزاً فاضحاً لمصلحة الأقوياء في السياسة على حساب الفقراء والضعفاء. تقدّم لهم حقوق الإنسان والمساواة بين المرأة والرجل فيما نحن ما زلنا، في معظم المجتمعات المدعوة إسلاميّة، نربّي الأطفال على القمع، ونضطهد النساء ونبارك منظومات تشريعيّة تنتقص من حقوقهنّ المجتمعيّة والجنسيّة. والحقّ أنّنا نقوم بكلّ هذا باسم ذكوريّة تافهة تعيد إنتاج ذاتها عبر استعادة نصوص دينيّة على نحو إطلاقيّ يتجاهل تطوّر المجتمعات وحركيّة التغيّر في العقول والذهنيّات. وتقدّم أوروبّا لهؤلاء الحرّيّة، وهي قيمة متأصّلة في الكتب الدينيّة، حيث يدعو الله الإنسان إلى اختيار الخير ونبذ الشرّ، وتشكّل بالاستناد إلى الخبرة التاريخيّة أعمق ما يكوّن وعي الإنسان بالنسبة إلى ماهيّة ذاته. هذه الحرّيّة ما زالت تعتريها في معظم المجتمعات الإسلاميّة نواقص في التشريع وفي الأداء المجتمعيّ، وغالباً ما نسمع ممثّلي المؤسّسات الدينيّة يذمّونها بالاستناد إلى حجج خرقاء. كيف نفسّر الشرخ بين القيم الإنسانيّة العليا التي تدافع عنها أوروبّا وتجعلها نبراس حسّها المجتمعيّ وغالبيّة المجتمعات الإسلاميّة؟ الجواب التبسيطيّ هو أن يقال إنّ المشكلة تكمن في الإسلام ذاته. الجواب تبسيطيّ، أوّلاً، لأنّه ليس ثمّة إسلام منفصل عن المسلمين. فالدين في تمظهره المجتمعيّ يرتبط بأحوال البشر الأفراد ومخزوناتهم الثقافيّة وسلوكيّاتهم، وهذه متنوّعة ولا يمكن اختزالها. أستاذة الطبّ المسلمة ذات التوجّه العلمانيّ في بيروت تلتقي مع المتصوّف المولويّ في اسطنبول على الانتساب إلى الدين ذاته من حيث الأركان والمنطلقات. ولكنّ هناك آلاف الظلال التي تميّز إسلام كلًّ منهما في المقترب الذهنيّ والثقافة والسلوك والعلاقة مع التراث. نكران هذه الظلال أو محاولة إبطالها هما من باب التهويم الإيديولوجيّ. وجواب كهذا تبسيطيّ، ثانياً، لأنّ لكلّ مجتمع من المجتمعات الإسلاميّة حكايته مع التاريخ، وهذه الحكاية صاغته وشكّلته. تاريخ الإسلام في إندونيسيا ليس إيّاه تاريخ الإسلام في إيران. والتاريخ ينشئ اختلافاً في الوعي واختلافاً في الحسّ. من لا يلتفت إلى كلّ هذا التنوّع، يقع في فخّ جعل الإسلام مرادفاً للإرهاب والعنف. وإطلاق الأحكام التعميميّة من خارج الإلمام بالشرط التاريخيّ لا يدمّر الموضوعيّة فحسب، بل هو معرّض أيضاً لأن يغذّي سيكولوجيا عنفيّة متأصّلة في قيعان الذات الفرديّة والجماعيّة. ولكنّ نبذ الاختزال والتعميم يجب ألاّ يفضي بنا إلى تفادي السؤال. لقد آن الأوان أن ينبري المسلمون إلى تفحّص هذه المسألة بجدّيّة (وبعضهم منخرط في ذلك) عوضاً من أن ينصرفوا إلى دفاع رخيص عن الإسلام ونبيّه غالباً ما يسوق إلى تسطيح الأشياء وقذفها إلى دائرة الخطاب الشعبويّ. كيف نفسّر الافتراق بين غالبيّة المجتمعات الإسلاميّة والمنظومة القيميّة الإنسانيّة الحديثة؟ أيّ جواب جدّيّ على هذا السؤال لا بدّ له من أن يكون متعدّد الجوانب، إذ أغلب الظنّ أنّنا نتعامل مع قضيّة ذات عوامل متشابكة. ولكنّ الأكيد أنّ جزءاً من الردّ يكمن في علاقة الإسلام المأزومة بالحداثة الغربيّة. فهذه الحداثة هي التي تصنع كلّ شيء اليوم: تصنع الفكر وتصنع الثقافة وتصنع التكنولوجيا وتصنع الاقتصاد وتصنع التاريخ، بحيث يبدو الإسلام بإزائها هامشيّاً بعدما كان يمسك بناصية صنع الحضارة الإنسانيّة طوال قرون. وفق هذا المنطق، يبدو الإسلام حيال الحضارة الغربيّة أشبه بالملك المخلوع عن عرشه رغم مملكته المترامية. في هذه العمليّة التحليليّة المعقدّة الثنيّات التي يتعيّن على العقل الإسلاميّ أن يخوضها بنزاهة فكريّة وشفافيّة وانفتاح على كلّ احتمالات المساءلة والمراجعة والتصويب، لا بدّ من إلقاء البال إلى أمرين: إشكاليّة تأويل النصوص الدينيّة وإشكاليّة الحرّيّة. ما خلا استثناءات قليلة مهمّة ولكنّها قليلة التأثير على وجه العموم، تدور عمليّة تأويل النصّ القرآنيّ ونصوص التراث الإسلاميّ اليوم في حلقة شبه مفرغة. فمن يمسك بناصية التفسير والتشريع في العالم الإسلاميّ، ولا سيّما المؤسّسات والحوزات المدعوة «علميّة»، ما زال يقوم بالعمليّة التأويليّة والتشريعيّة بالاستناد إلى مجموعة من علوم الدين الموسومة بختم الماضي، وذلك في انقطاع كلّيّ عن كلّ ما أنتجته العلوم الإنسانيّة الحديثة، كالتاريخ وعلم الآثار وعلم الاجتماع وعلم النفس، من مناهج حديثة في فهم النصوص وتأويلها. طبعاً، جزء من هذه المعضلة يكمن في أنّ هذه العلوم غربيّة الطابع ولصيقة بالحداثة الآتية من الغرب. ولكنّ المسلمين في الماضي تفاعلوا مع علوم اليونان والفرس والهند ولم يقولوا: هذا منتج من خارج «الأمّة» لا يسوغ الأخذ به. فلماذا يحجمون اليوم عن المنتج العلميّ الغربيّ؟ مشكلة العقل الإسلاميّ اليوم مردّها أنّ العلوم الإنسانيّة التي أتينا على ذكرها تشكّل، من جهة، وعي كثيرين من المسلمين حول العالم. ولكن حين نأتي إلى علوم الدين، من جهة أخرى، فإنّ هذه تبدو أشبه بمنظومات ماضويّة مقفلة وغير قادرة على مجاراة العصر وما يتّصف به من تبدّلات ثقافيّة وذهنيّة. هذا الافتراق بين العلوم الحديثة وعلوم الدين ينشئ فصاماً يدفع المسلمون ثمنه فيما معظم حوزاتهم العلميّة تخشى الانزياحات إمّا بضغط السياسة أو محافظةً على سلطتها وإمعاناً في تسلّطها. المسلمون اليوم لا يحتاجون إلى «إحياء» لعلوم الدين، بل إلى تجديد لهذه العلوم عبر استلهام الإنسانيّات الحديثة، مع كلّ ما تستبطنه هذه العمليّة الجريئة والشاقّة من تبدّل في استقراء احتمالات العلاقة بين المعطى الإلهيّ والمعطى الإنسانيّ. الأمر الثاني هو قضيّة الحرّيّة. لا يقعنّ أحد في الوهم. لن يتراجع الإيمان بالحرّيّة الإنسانيّة في الفكر والتعبير. وهذه الحرّيّة مسؤولة أمام ذاتها فقط، ولا أحد يرسم لها قنوات وحدوداً لا باسم مراعاة المشاعر الدينيّة ولا بالاستناد إلى أيّ معيار آخر. فمن يكمّ اليوم الأفواه لئلاّ يشعر المسلمون بأنّ نبيّهم يهان، ربّما سوّغت له نفسه غداً أن يكمّها باسم العرق أو الجنس أو الانتماء القوميّ. هل هذا ما نريده؟ لا يلعبنّ أحد هذه اللعبة مع الحرّيّة باسم الدين والدفاع عن الأنبياء والمرسلين. فالحرّيّة كنز ثمين لا يفرّط به، والأنبياء لا يحتاجون إلى من يدافع عنهم. يضاف إلى ذلك أنّ جزءاً من هذه الحرّيّة هو نقد الدين. هذا النقد لم تخترعه الحداثة الغربيّة ولا هو لقيط الدوريّات الكاريكاتوريّة الفرنسيّة. أوّل من مارس نقد الدين كان الأنبياء ذاتهم من ابرهيم إلى محمّد مروراً بعيسى المسيح، ومن بعدهم فلاسفة ودعاة دينيّون كثر. لولا هذا النقد، لما تدرّب البشر على إقامة تمييز ممدوح بين الدين الأصيل والدين الكاذب ولظلّوا يتخبّطون في مستنقع الأسطرة وتفتك بهم دودة الخلط بين الدين والخرافة. حذار من اللعب مع الحرّيّة باسم الدين. فالتجربة التاريخيّة التراكميّة تثبت أنّ لعبةً من هذا النوع غالباً ما تكون خاسرة. وحتّى لو ربحها الدين، فإنّه يخسر ذاته، إذ ماذا يبقى من الدين إذا انتفت الحرّيّة الإنسانيّة؟ |
Telosقضايا حاليّة أرشيف
|
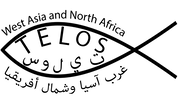
 RSS Feed
RSS Feed